ويكي بيانات. تنزيل بصيغة
|
|
قال محمد بن زكريا الرازي: أكمل الله للأمير السعادة وأتم علية النعمة. جرى بحضرة الأمير - أطال الله بقاءه - ذكر مقالة عملتُها في إصلاح الأخلاق سألنها بعض اخوتي بمدينة السلام أيام مُقامي بها، فأمر سيدي الأمير - أيده الله - بإنشاء كتاب يحتوي على جُمَل هذا المعنى بغاية الاختصار والإيجاز وأن أسمه بالطب الروحاني، فيكون قريناً للكتاب المنصوري الذي غرضه في الطب الجسماني وعديلاً له، لِما قدر-أدام إليه من عموم النفع وشموله للنفس والجسد. فانتهيتُ إلى ذلك وقدمته على سائر شغلي، والله أسأل التوفيق لِما يُرضي سيدي الأمير ويقرب إليه ويُدني منه.
وقد فصلت هذا الكتاب عشرين فصلاً: الأول في فضل العقل ومدحه الثاني في قمع الهوى وردعه وجملة من رأي أفلاطون الحكيم الثالث جملة قُدمت قبل ذكر عوارض النفس الرديئة على انفرادها الرابع في تعرف الرجل عيوب نفسة الخامس في دفع العشق والألف وجملة من الكلام في اللذة السادس في دفع العُجب السابع في دفع الحسد الثامن في دفع المفرط الضار من الغضب التاسع في اطراح الكذب العاشر في اطراح البخل الحادي عشر في دفع الفضل الضار من الفكر والهم الثاني عشر في صرف الغم الثالث عشر في دفع الشَرَه الرابع عشر في دفع الانهماك في الشراب الخامس عشر في دفع الاستهتار بالجماع السادس عشر في دفع الولع والعبث والمذهب السابع عشر في مقدار الاكتساب والاقتناء والإنفاق الثامن عشر في المجاهدة والمكادحة على طلب الرُتَب والمنازل الدنيائية والفرق بين ما يُرى الهوى وبين ما يُرى العقل التاسع عشر في السيرة الفاضلة العشرون في الخوف من الموت.
في فضل العقل ومدحه
أقول: إن البارئ عز اسمه إنما أعطانا العقل وحبانا به لننال ونبلغ به من المنافع العاجلة والآجلة غاية ما في جوهرِ مِثلنا نيلُه وبلوغه، وإنه أعظم نِعَم الله عندنا وأنفع الأشياء لنا وأجدها علينا. فبالعقل فُضلنا على الحيوان غير الناطق حتى ملكناها وسُسناها وذللناها وصرفناها في الوجوه العائدةِ منافعُها علينا، وبالعقل أدركنا جميع ما يرفعنا ويُحسن ويطيب به عيشنا ونصل إلى بغيتنا ومرادنا. فأنا بالعقل أدركنا صناعة السُفُن واستعمالها حتى وصلنا بها إلى ما قطع وحال البحر دوننا ودونه، وبه نلنا الطب الذي فيه الكثير من مصالح أجسادنا وسائر الصناعات العائدة علينا النافعة لنا، وبه أدركنا الأمور الغامضة البعيدة منا الخفية المستورة عنا، وبه عرفنا شكل الأرض والفلك وعظم الشمس والقمر وسائر الكواكب وأبعادها وحركتها، وبه وصلنا إلى معرفة البارئ عز وجل الذي هو أعظم ما استدركنا وأنفع ما أصبنا. وبالجملة فإنه الشيء الذي لولاه كانت حالتنا حالة البهائم والأطفال والمجانين، والذي به نتصور أفعالنا العقلية قبل ظهورها للحس فنراها كأن قد أحسسناها ثم نتمثل بأفعالنا الحسية صورها فتظهر مطابقة لِما تمثلناه وتخيلناه منها. وإذا كان هذا مقداره ومحله وخطره وجلالته فحقيق علينا أن لا نحطّه عن رتبته ولا ننّزله عن درجته، ولا نجعله وهو الحاكم محكوماً عليه، ولا وهو الزمام مزموماً، ولا وهو المتبوع تابعاً، بل نرجع الأمور إليه ونعتبرها به ونعتمد فيها عليه، فنُمضيها على إمضائه ونوقفها على إيقافه، ولا نسّلط عليه الهوى الذي هو آفتهُ ومكدِّره والحائد به عن سنَنَه ومحجّته وقصده واستقامته، والمانع من أن يصيب به العاقل رشده وما فيه عواقب أمره، بل نروضه ونذللهُ ونحمِله ونجبره على الوقوف عند أمره ونهيه. فإنّا إذا فعلنا ذلك صفا لنا غايةَ صفائه وأضاء لنا غايةَ إضاءته وبلغ بنا نهايةَ قَصْدِ بلوغنا به. وكنا سعداء بما وهب الله لنا منه ومنّ علينا به.
في قمع الهوى وردعه وجملة من رأي أفلاطون الحكيم
أما على أثر ذلك فإنّا قائلون في الطب الروحاني الذي غايته إصلاح أخلاق النفس وموجزون غاية الإيجاز. والقصد والمبادرة إلى التعلق بالنكت والعيون والمعاني التي هي أصول جملة هذا الغرض كله. فنقول: إنا قد صدرنا وقدمنا من العقل والهوى ما رأينا أنه لجملة هذا الغرض كله بمنزلة المبدأ، ونحن متْبعوه من أصول هذا الشأن بأجْلها وأشرافها فنقول: إنّ أشرف الأصول وأجلها وأعونها على بلوغ غرض كتابنا هذا قمع الهوى ومخالفة ما يدعو إليه الطباع في أكثر الأحوال وتمرين النفس على ذلك وتدريجها إليه، فإن أول فضل الناس على البهائم هو هذا، أعنى ملكة الإرادة وإطلاق الفعل بعد الروية. وذلك أن البهائم غير المؤدبة واقفة عند ما يدعوها إليه الطباع عاملة به غير ممتنعة منه ولا مروَّية فيه. فإنك لا تجد بهيمةً غير مؤدبة تمسك عن أن تروث أو تتناول ما تتغذى به مع حضوره وحاجتها إليه، كما تجد الإنسان يترك ذلك ويقهر طباعه عليه لمعانٍ عقلية تدعوه إلى ذلك، بل تأتي منها ما يبعثها عليه الطباع غير ممتنعة منه ولا مختارة عليه. وهذا المقدار ونحوه من الفضل على البهيمة في زمّ الطبع هو لأكثر الناس وإن كان ذلك تأديبا وتعليما، إلا أنه عام وشامل وقريب واضح يعتاده الطفل وينشأُ عليه، ولا يحتاج إلى الكلام فيه، على أن في ذلك بين الأمم تفاضُلاً كثيراً وبوناً بعيداً. وأمّا البلوغ من هذه الفضيلة أقصى ما يتهيأ في طباع الإنسان فلا يكاد يكمله إلاّ الرجل الفيلسوف الفاضل. وبمقدار فضل العوامّ من الناس على البهائم في زمّ الطبع والملكة للهوى ينبغي أن يكون فضل هذا الرجل على العوامّ. ومن هاهنا نعلم أنّ مَن أراد أن يزين نفسة بهذه الزينة ويكمل لها هذه الفضيلة فقد رام أمراً صعباً شديداً ويحتاج أن يوطن نفسه على مجاهدة الهوى ومجادلته ومخالفته. ولأن بين الناس في طباعهم اختلافاً كثيراً وبوناً بعيداً صار يسهل أو يعسر على البعض دون البعض منهم اكتسابُ بعض الفضائل دون بعض واطراح بعض الرذائل دون بعض. وأنا مبتدئ بذكر كيفية اكتساب هذه الفضيلة - أعني قمع الهوى ومخالفته - إذ كانت أجلّ هذه الفضائل وأشرفها وكان محّلها من جملة هذا الغرض كلّه محلّ الاسطقس التالي للمبدأ.
فأقول: إنّ الهوى والطباع يدعوان أبداً إلى إتّباع اللذّات الحاضرة وإيثارها من غير فكر ولا رويّة في عاقبة ويحثّان عليه ويُعجلان إليه، وإن كان جالباً للألم من بعد ومانعاً من اللذّة ما هو أضعافٌ لِما تقدّم منها. وذلك أنهما لا يريان إلا حالتهما في الذي هما فيه لا غير، وليس بهما إلاّ إطّراح الألم المؤذي عنهما وقتَهما ذلك، كإثار الطفل الرَمِد حكَّ عينيه وأكلَ التمر واللعبَ في الشمس. ومن اجل ذلك يحقّ على العاقل أن يردعهما ويقمعهما ولا يُطلقهما إلاّ بعد التثبُّت والنظر فيما يُعقبانه ويمثّلَ ذلك ويزنَه ثم يتبعَ الأَرجح لئلاّ يألم من حيث ظنّ أنه يلّتذّ ويحسر من حيث ظنّ أنه يربح. فإن دخلت عليه من هذا التمثيل والموازنة شبهة لم يُطلق الشهوة لكن يقيم على ردعها ومنعها. وذلك أنه لا يأمن أن يكون في لإطلاقها من سوء العاقبة ما يكون إيلامه واحتمال مؤو نته أكثر من احتمال مؤونة الصبر على قمعها أضعافاً مضاعَفةً، فالحزم إذاً في منعها. وإن تكافأت عنده المؤونتان أقام أيضاً على ردعها، وذلك أنّ المرارة المتجرِّعة أهون وأيسر من المنتظَرة التي لابدّ من تجرُّعها على الأمر الأكثر. وليس يكتفي بهذا فقط بل ينبغي أن يقمع هواه في كثير من الأحوال - وإن لم ير لذلك عاقبةً مكروهةً - ليمرّن نفسه ويروضها على احتمال ذلك واعتياده فيكون ذلك عليها عند العواقب الرديئة أسهل، ولئلا تتمكن الشهوات منه وتتسلّط عليه. فإن لها من التمكّن في نفس الطبيعة والجبّلة ما لا يحتاج أن يُزاد فضل تمكّن فضل تمكنٍ بالعادة أيضاً فيصيرَ بحالٍ لا يمكن مقاومتُها بتّةً. وينبغي أن تعلم أن المؤثرين للشهوات المدمنين لها المنهمكين فيها يصيرون منها إلى حالة لا يلتذّونها ولا يستطيعون مع ذلك تركها فإنّ المدمنين لغشيان النساء وشرب الخمور والسماع - على أنها من أقوى الشهوات وأوكدها غرزاً في الطباع - لا يلتذونها التذاذَ غير المدمنين لها لأنها تصير عندهم بمنزلة حالةٍ عنده، أعني المألوفة المعتادة، ولا يتهيّأ لهم الإقلاع عنها لأنها قد صارَت عندهم بمنزلة الشيء الاضطراري في العيش لا بمنزلة ما هو فضل وتترُّفٌ. ويدخل عليهم من أجلها التقصير في دينهم ودنياهم حتى يُضطرّوا إلى استعمال صنوف الحِيَل واكتساب الأموال بالتغرير بالنفس وطرحها في المهالك، فإذا هم شقوا من حيث قدّروا السعادة واغتنّموا من حيث قدّروا الفرح وألموا من حيث قدروا اللذّة. وما أشبههم في هذا الموضع بالحاطب على نفسه الساعي في هلاكها، كالحيوان المخدوعة بما يُنصب لها في مصايدها، حتى إذا حصلت في المصيدة لم تنل ما خُدعت به ولا أطاقت التخلُّص ممّا وقعت فيه. وهذا المقدار من الشهوات مُقنع، وهو أن يُطلَق منها ما عُلم أنّ عاقبتة لا تجلب ألَماً ولا ضَرَراً دنيائيٍّا موازياً للذّة المُصابة منها فضلاً عمّا تجلب ممّا يُوفى ويرجح على اللّذة التي أُصيبت في صدرها. وهذا يراه ويقول به ويوجب حمل النفس عليه مَن كان من الفلاسفة ل يرى أنّ للنفس وجوداً بذاتها، ويرى أنها تفسد بفساد الجسم الذي هي فيه. فأمّا مَن يرى أنّ للنفس أنيّةً وذاتاً مّا قائمة بنفسها وأنها تستعمل الجسم الذي لها بمنزلة الأداة والآلة وأنها لا تفسد بفساده فيرتقون من زمّ الطباع ومجاهدة الهوى ومخالفته إلى ما هو أكثر من هذا كثيراً جداً، ويرذلون ويستنقصون المنقادين له والمائلين معه تنقُّصاً شديداً ويحلّونهم محلّ البهائم، ويرون أنّ لهم - في اتّباع الهوى وإيثاره والميل مع اللذّات والحبّ لها والأسف على ما فات منها وإيلام الحيوان لبلوغها ونيلها - عواقبَ سوءٍ بعد مفارقة النفس للجسد يكثر ويطول لها ألمها وأسفها وحسرتها. وقد يستدل هؤلاء من نفس هيئة الإنسان على أنه لم يتهيّأ للشغل باللذّات والشهوات بل لاستعمال الفكر والرويّة من تقصيرة في ذلك عن الحيوان غير الناطق. وذلك أنّ البهيمة الواحدة تُصيب من لذّة المأكل والمنكح ما لا يصيبه ولا يقدر عليه عدد كثير من الناس. فأمّا حالها في سقوط الهّم والفكر عنها وهناءة عيشها وطيبها بذلك فحالة لا يصيب الإنسان ولا يقدر على مثالها بتّةً، وذلك أنها من هذا المعنى في الغاية والنهاية. فإنّا نرى البهيمة قد حضر وقت ذبحها وهي منهمكة مقبلة على مأكلها ومشربها. قالوا: فلو كانت إصابة الشهوات والميل مع دواعي الطباع هو الأفضل لم يكن يُبخسُه الإنسان ويُعطاه ما هو أخس منه من الحيوان. وفي بخس الإنسان وهو أفضل الحيوان المائت حظَّه من هذه الأشياء وتوفر الحظ له من الروية والفكر ما يُعلم منه أن الأفضل له استعمال النطق وتزكيته لا الاستعباد والانقياد لدواعي الطباع قالوا: ولئن كان الفضل في إصابة اللذات والشهوات ليكونون من له الطباع المتهئ لذلك أفضل ممن ليس له ذلك، فإن كان كذلك فالثيران والحمير أفضل من الناس لا بل ومن الحيوان غير المائت كله ومن البارئ عزّ وجلّ إذ ليس بذى لذّة ولا شهوة قالوا: ولعل بعض الناس ممن لا رياضة له ولا يروِّى ولا يفكر في أمثال هذه المعاني لا يُسلِّم لنا أن البهائم تصيب من اللذّة أكثر مما يصيبه الناس. ويحتجّ علينا بمَلِكٍ ما ظفر بعدو منازع ثم جلس من وقته ذلك للهو واحتشد في إظهار جميع زينته وهيئته حتى بلغ من ذلك غاية ما يمكن الناس بلوغهُ، فيقول أين التذاذ البهيمة من التذاذ هذا وهل له عنده مقدار وله إليه نسبة؟ فليعلم قائل هذا أنّ كمال اللذّة ونقصانها ليس يكون بالإضافة من بعضها إلى بعض بل بالإضافة إلى مقدار الحاجة إليها. فإنّ مَن لا يُصلِح حاله إلاّ ألفُ دينار إن أُعطِيَ منها تسع مائة وتسعة وتسعين ديناراً لم يتم له صلاح حاله تلك. ومَن كان يُصلح حالَه الدينارُ الواحد يتم له صلاحُ حالته بإصابة ذلك الدينار الواحد، على أنّ الأوّل قد أُعطِيَ أضعاف هذا فلم يكمل له صلاح حالته. والبهيمة إذا تَوَفَّر عليها ما يدعوها إليه الطباع كمل وتمّ التذاذها بذلك، ولا يضرها ولا يؤلمها فوت ما وراء ذلك إذ كان لا يخطر لها ببال بتّةً. على أنّ للبهيمة فضل اللذّة أبداً على كل حال. وذلك أنه ليس أحد من الناس يقدر أن يبلغ كل أمانيه وشهواته، لأنّ نفسه لمّا كانت نفساً مفكرةً مروِّيةً متصوِّرةً للغائب عنه وكان في طباعها أن لا تكون لذي حال حالة إلاّ وتكون حالتها هي الأفضل، لا تخلو في حالة من الأحوال من التشوُّق والتطلُّع إلى ما لم تَحْوِه والخوف والإشفاق على ما قد حوته، فلا تزال لذلك في نقص من لذّتها وشهوتها. فإنّ إنساناً لو ملك نصف الأرض لنازعته نفسه إلى ما بقى منها وأشفقت وخافت من تفلُّت ما حصل له منها، ولو ملك الأرض بأسرها لتمنَّى دوام الصحة والخلود وتطلّعت نفسه إلى علم خبر جميع ما في السماوات والأرضين. ولقد بلغني عن بعض الملوك الكبار الأنفس أنه ذُكِرَ عنده ذات يوم الجنة وعظيم ما فيها من النعيم مع الخلود، فقال أمّا أنا فإنِّي أتنغص هذا النعيم وأستمره إذا فكرت بأنِّي منزَّل فيها منزلة المُفضَّل عليه المُحَسن إليه. فمتى يتم التذاذ هذا واغتباطه بما هو فيه، وهل المغتبط عند نفسه إلاّ البهائم ومن جرى مجراها؟ كما قال الشاعر: هو الأفضل لم يكن يُبخسُه الإنسان ويُعطاه ما هو أخس منه من الحيوان. وفي بخس الإنسان وهو أفضل الحيوان المائت حظَّه من هذه الأشياء وتوفر الحظ له من الروية والفكر ما يُعلم منه أن الأفضل له استعمال النطق وتزكيته لا الاستعباد والانقياد لدواعي الطباع قالوا: ولئن كان الفضل في إصابة اللذات والشهوات ليكونون من له الطباع المتهئ لذلك أفضل ممن ليس له ذلك، فإن كان كذلك فالثيران والحمير أفضل من الناس لا بل ومن الحيوان غير المائت كله ومن البارئ عزّ وجلّ إذ ليس بذى لذّة ولا شهوة قالوا: ولعل بعض الناس ممن لا رياضة له ولا يروِّى ولا يفكر في أمثال هذه المعاني لا يُسلِّم لنا أن البهائم تصيب من اللذّة أكثر مما يصيبه الناس. ويحتجّ علينا بمَلِكٍ ما ظفر بعدو منازع ثم جلس من وقته ذلك للهو واحتشد في إظهار جميع زينته وهيئته حتى بلغ من ذلك غاية ما يمكن الناس بلوغهُ، فيقول أين التذاذ البهيمة من التذاذ هذا وهل له عنده مقدار وله إليه نسبة؟ فليعلم قائل هذا أنّ كمال اللذّة ونقصانها ليس يكون بالإضافة من بعضها إلى بعض بل بالإضافة إلى مقدار الحاجة إليها. فإنّ مَن لا يُصلِح حاله إلاّ ألفُ دينار إن أُعطِيَ منها تسع مائة وتسعة وتسعين ديناراً لم يتم له صلاح حاله تلك. ومَن كان يُصلح حالَه الدينارُ الواحد يتم له صلاحُ حالته بإصابة ذلك الدينار الواحد، على أنّ الأوّل قد أُعطِيَ أضعاف هذا فلم يكمل له صلاح حالته. والبهيمة إذا تَوَفَّر عليها ما يدعوها إليه الطباع كمل وتمّ التذاذها بذلك، ولا يضرها ولا يؤلمها فوت ما وراء ذلك إذ كان لا يخطر لها ببال بتّةً. على أنّ للبهيمة فضل اللذّة أبداً على كل حال. وذلك أنه ليس أحد من الناس يقدر أن يبلغ كل أمانيه وشهواته، لأنّ نفسه لمّا كانت نفساً مفكرةً مروِّيةً متصوِّرةً للغائب عنه وكان في طباعها أن لا تكون لذي حال حالة إلاّ وتكون حالتها هي الأفضل، لا تخلو في حالة من الأحوال من التشوُّق والتطلُّع إلى ما لم تَحْوِه والخوف والإشفاق على ما قد حوته، فلا تزال لذلك في نقص من لذّتها وشهوتها. فإنّ إنساناً لو ملك نصف الأرض لنازعته نفسه إلى ما بقى منها وأشفقت وخافت من تفلُّت ما حصل له منها، ولو ملك الأرض بأسرها لتمنَّى دوام الصحة والخلود وتطلّعت نفسه إلى علم خبر جميع ما في السماوات والأرضين. ولقد بلغني عن بعض الملوك الكبار الأنفس أنه ذُكِرَ عنده ذات يوم الجنة وعظيم ما فيها من النعيم مع الخلود، فقال أمّا أنا فإنِّي أتنغص هذا النعيم وأستمره إذا فكرت بأنِّي منزَّل فيها منزلة المُفضَّل عليه المُحَسن إليه. فمتى يتم التذاذ هذا واغتباطه بما هو فيه، وهل المغتبط عند نفسه إلاّ البهائم ومن جرى مجراها؟ كما قال الشاعر:
وهل يَنْعَمَنْ إلاّ سعيد مخَّلد ... قليل الهموم ما يبيت بأوجال
وهذه العصابة من المتفلسفة تترقَّى من زمّ الهوى ومخالفته بل من إهانته وإماتته إلى أمر عظيم جداً، حتى إنها لا تنال من المأكل والمشرب إلاّ قوتاً وبُلغةً ولا تقتني مالاً ولا عقاراً ولا داراً. وربما أقدم الموغلِ منهم في هذا الرأي على اعتزال الناس والتخلَّي منهم ولزوم المواضع الغامرة. وبهذا ونحوه يحتجوّن لصحّة رأيهم من الأشياء الحاضرة المشاهدة. فأمّا ما يحتجون به له من أحوال النفس بعد مفارقتها للبدن فإنّ الكلام فيه يجاوز مقدار هذا الكتاب في شرفه وفي طوله وفي عرضه. أمّا في شرفه فإنه يُبحث فيه عن النفس ما هي ولِمَ هي مع الجسم ولِمَ تفارقه وما تكون حالها بعد مفارقته، وأما طوله فلأنّ كل واحد من هذه البحوث يحتاج في تعبيره وحكايته إلى أضعاف أضعاف ما في هذا الكتاب من الكلام، وأما في عرضه فلأنّ قصد هذه المباحث هو إلى صلاح حال النفس بعد مفارقتها للجسد وإن كان قد يعرض فيه باشتراك الكلام أكثر إصلاح الأخلاق. ولا بأس أن نحكي منه جملة وجيزة من غير أن نتلبس فيه باحتجاج لهم أو عليهم، ونقصد منه خاصةً للمعاني التي نظنّ أنها تُعين على بلوغ غرض كتابنا هذا وتقوِّى عليه.
فنقول: إنّ فلاطن شيخ الفلاسفة وعظيمها يرى أنّ الإنسان ثلاث أنفس يسمِّى إحداها النفس الناطقة والإلهّية والأخرى يسميّها النفس الغضّبية والحيوانية والأخرى النفس النباتية والنامية والشهوانية. ويرى أنّ النفسين الحيوانية والنباتية إنما كوّنتا من أجل النفس الناطقة. أما النباتية فلتغدو الجسم الذي هو للنفس الناطقة بمنزلة آلة وأداة إذ ليس هو من جوهر باقٍ غير متحلِّل بل من جوهر سيّال متحلّل، وكان كل متحلّل لا يبقى إلاّ بأن يخلف فيه بدلاً ممّا تحلل منه. فأما الغضبية فلتستعين بها النفس الناطقة على قمع النفس الشهوانية ومنعها من أن تشغل النفس الناطقة بكثرة شهواتها عن استعمال نطقها الذي إذا استعملته كَمَلاً كان في ذلك تخلُّصها من الجسم المشتبكة به. وليس لهاتين النفسين - أعني النباتية والغضبيّة - عنده جوهر خاص يبقى بعد فساد الجسم كجوهر النفس الناطقة، بل إحداها وهي الغضبيّة هي جملة مزاج القلب والأخرى وهي الشهوانية هي جملة مزاج الكبد. وأما جملة مزاج الدماغ فإنها عنده أول آلة وأداة تستعملها النفس الناطقة. والأغتذاء والنمو والنشوء للإنسان من الكبد، والحرارة وحركة النبض من القلب. وأما الحس والحركة الإرادية والتخُّيل والفكر والذكر فمن الدماغ، لا على أنّ ذلك من خاصيّتّه ومزاجه بل من الجوهر الحال فيه المستعمل له على استعمال آلة وأداة، إلا أنه أقرب الآلات والأدوات إلى هذا الفاعل. ويرى أن يجتهد الإنسان بالطب الجسداني وهو الطب المعروف، والطبِّ الروحاني وهو الإقناع بالحجج والبراهين في تعديل أفعال هذه النفوس لئلا تقصِّر عمّا أُريد بها ولئلا تجاوزه. والتقصير في فعل النفس النباتية أن تغدو ولا تُنمى ولا تُنشئ بالكمية والكيفية المحتاجة إليها جملةُ الجسد. وإفراطها أن تتعدى ذلك وتجاوزه حتى يخصب الجسد فوق ما يحتاج إليه ويغرق في اللذّات والشهوات. وتقصير فعل النفس الغضبية أن لا يكون عندها من الحمية والأنفة والنجدة ما يمكِّنها أن تزمَّ وتقهر النفس الشهوانية في حال اشتهائها حتى تحول دونها ودون شهواتها، وإفراطه أن يكثر فيها الكِبر وحُبّ الغلبة حتى تروم قهر الناس وسائر الحيوان ولا يكون لها همّ إلا الاستعلاء والغلبة كالحالة التي كان عليها الاسكندر الملك. وتقصير فعل النفس الناطقة أن لا يخطر ببالها استغراب هذا العالم واستكباره والفكر فيه والتعجُّب منه والتطلُّع والتشّوُق إلى معرفة جميع ما فيه وخاصةً علم جسدها الذي هي فيه وهيئته وعاقبته بعد موته، فإنّ مَن لم يستكبر ويستغرب هذا العالم ولم يتعجب من هيئته ولم تتطّلع نفسه إلى معرفة جميع ما فيه ولم يهتمّ ويُعْنَ بتعرُّف ما تؤول إليه الحال بعد الموت فنصيبه من النطق نصيب البهائم لا بل الخُفاش والحيتان والخُشار التي لا تتفكّر ولا تتذكر البتة. وإفراطه أن يميل به ويستحوذ عليه الفكرُ في هذه الأشياء ونحوها حتى لا يمكن النفس الشهوانية أن تنال من الغذاء وما به يصلح الجسم من النوم وغيره مقدارَ ما تحتاج إليه في بقاء مزاج الدماغ على حالة الصحّة، لكن يبحث ويتطلع ويجتهد غاية الجهد ويقدِّر بلوغ هذه المعاني والوصول إليها في زمان أقصر من الزمان الذي لا يمكن بلوغها إلاّ فيه، فيفسد حينئذ مزاج جملة الجسد حتى يقع في الوسواس السوداوي والملنخوليا ويفوته ما طلب من حيث قدّر سرعة الظفر به. ويرى أنّ المدّة التي جُعلت لبقاء هذا الجسد المتحلل الفاسد بالحال التي يمكن النفس الناطقة استعمالها فيما تحتاج إليه لصلاح أمرها بعد مفارقته - وهي المدّة التي منذ حين يولد الإنسان إلى أن يهرم ويذبل - مدةٌ يفي فيها كل أحد، ولو كان أبلد الناس بعد أن لا يضرب عن الفكر والنظر البتّة، بالتطلُّع على المعاني التي ذكرنا أنها تخصّ النفس الناطقة وبأن يرذل هذا الجسدَ والعالم الجسدانيّ البتّة ويشنأه ويبغضه، ويعلَمَ أنّ النفس الحسّاسة ما دامت متعلقة بشيء منه لم تزل في أحوال مؤذية مؤلمة من أجل تداول الكون والفساد إياه، ولا يكرهَ بل يشتاق إلى مفارقته والتخلُّص منه. ويرى أنه متى كانت مفارقة النفس الحساسة للجسد الذي هي فيه وقد اكتسبت هذه المعاني واعتقدتها صارت في عالمها ولم تشتق إلى التعلُّق بشيء من الجسم بعد ذلك البتّة، وبقيت بذاتها حيةً ناطقةً غير مائتة ولا آلمة مغتبطةَ بموضعها ومكانها. أمّا الحيوية والنطق فلها من ذاتها، وأما بُعدها عن الألم فلبُعدها عن الكون والفساد، وأما اغتباطها بمكانها وعالمها فلتخلُّصها من مخالطة الجسم والكونِ في العالم الجسداني. وأنه متى كانت مفارقتها للجسد وهي لم تكتسب هذه المعاني ولم تعرف العالم الجسداني حقَّ معرفته بل كانت تشتاق إليه وتحرص على الكون فيه لم تبرح مكانها ولم تزل متعلقة بشيء منه، ولم تزل - لتداول الكون والفساد للجسد الذي هي فيه - في آلام متصلة مترادفة وهموم جمّة مؤذية. فهذه جملةٌ من رأي فلاطن ومِن قبله سقراط المتخِّلي المتألِّه. وبعدُ فما من رأيٍ دنيائي قطُّ إلاّ ويُوجب شيئاً من زمّ الهوى والشهوات ولا يُطلق إهمالها وإمراجها، فزمُّ الهوى وردعه واجب في كل رأي وعند كل عاقل وفي كل دين. فليلاحظ العاقل هذه المعاني بعين عقله ويجعلها من همّه وباله. وإن هو لم يكتسب من هذا الكتاب أعلى الرُتَب والمنازل في هذا الباب فلا أقل من أن يتعلق ولو بأخس المنازل منه، وهو رأيُ مَن رأي زمَّ الهوى بمقدار ما لا يجلب ضرراً عاجلاً دنيائيّاً. فإنه وإن تجرع في صدور أموره من زمّ الهوى وقمعه مرارةً وبشاعةً فستُعقبه أردافها حلاوةً ولذاذةً يغتبط بها ويعظم بها سروره وارتياحه عندها، مع أنّ المؤونة في احتمال مغالبة الهوى وقمع الشهوات ستخف عليه بالاعتياد ولا سيّما إذا كان ذلك على تدريج بأن يعّود نفسه ويأخذها أولاً بمنع اليسير من الشهوات وتركِ بعض ما تهوى لِما يوجبه العقل والرأي، ثم يروم من ذلك ما هو أكثر حتى يصير ذلك فيه مقارناً للخُلق والعادة وتذلّ نفسه الشهوانية وتعتاد الانقياد للنفس الناطقة. ثم يزداد ذلك ويتأكد عند سروره بالعواقب العائدة عليه من زمّ هواه وانتفاعه برأيه وعقله وسياسة أموره بهما ومدح الناس له على ذلك واشتياقهم إلى مثل حاله. يوية والنطق فلها من ذاتها، وأما بُعدها عن الألم فلبُعدها عن الكون والفساد، وأما اغتباطها بمكانها وعالمها فلتخلُّصها من مخالطة الجسم والكونِ في العالم الجسداني. وأنه متى كانت مفارقتها للجسد وهي لم تكتسب هذه المعاني ولم تعرف العالم الجسداني حقَّ معرفته بل كانت تشتاق إليه وتحرص على الكون فيه لم تبرح مكانها ولم تزل متعلقة بشيء منه، ولم تزل - لتداول الكون والفساد للجسد الذي هي فيه - في آلام متصلة مترادفة وهموم جمّة مؤذية. فهذه جملةٌ من رأي فلاطن ومِن قبله سقراط المتخِّلي المتألِّه. وبعدُ فما من رأيٍ دنيائي قطُّ إلاّ ويُوجب شيئاً من زمّ الهوى والشهوات ولا يُطلق إهمالها وإمراجها، فزمُّ الهوى وردعه واجب في كل رأي وعند كل عاقل وفي كل دين. فليلاحظ العاقل هذه المعاني بعين عقله ويجعلها من همّه وباله. وإن هو لم يكتسب من هذا الكتاب أعلى الرُتَب والمنازل في هذا الباب فلا أقل من أن يتعلق ولو بأخس المنازل منه، وهو رأيُ مَن رأي زمَّ الهوى بمقدار ما لا يجلب ضرراً عاجلاً دنيائيّاً. فإنه وإن تجرع في صدور أموره من زمّ الهوى وقمعه مرارةً وبشاعةً فستُعقبه أردافها حلاوةً ولذاذةً يغتبط بها ويعظم بها سروره وارتياحه عندها، مع أنّ المؤونة في احتمال مغالبة الهوى وقمع الشهوات ستخف عليه بالاعتياد ولا سيّما إذا كان ذلك على تدريج بأن يعّود نفسه ويأخذها أولاً بمنع اليسير من الشهوات وتركِ بعض ما تهوى لِما يوجبه العقل والرأي، ثم يروم من ذلك ما هو أكثر حتى يصير ذلك فيه مقارناً للخُلق والعادة وتذلّ نفسه الشهوانية وتعتاد الانقياد للنفس الناطقة. ثم يزداد ذلك ويتأكد عند سروره بالعواقب العائدة عليه من زمّ هواه وانتفاعه برأيه وعقله وسياسة أموره بهما ومدح الناس له على ذلك واشتياقهم إلى مثل حاله.
جملةٌ قُدّمت قبل ذكر عوارض النفس الرديئة على انفرادها
أما وقد وطأنا لما يأتي بعدُ من كلامنا أُسَّه وذكرنا أعظم الأصول في ذلك مما فيه غنىً وعليه معونةٌ فإنا ذاكرون من عوارض النفس الرديّة والتلُّطف لإصلاحها ما يكون قياساً ومثالاً لِما لم نذكره منها. ونتحرى الإيجاز والاختصار ما أمكن في الكلام فيها، إذ قدّمنا السبب الأعظم والعلة الكبرى التي منها نستقي وعليها نبني جميع وجوه التلطُّف لإصلاح خُلق ما ردى. حتى أنه لو لم يُفَرد ولا واحدٌ منها بكلام يخصه بل أُغفِلَ ولم يُذكر بتّةً لكان في التحفُّظ والتمسُّك بالأصل الأول غني وكفاية لإصلاحها، وذلك أنّ جُلها مما يدعو إليه الهوى وتحمل عليه الشهوات، وفي زمّ هذين وحفظهما ما يمنع التمسُّك والتخلُّق بهما. إلاّ أنّا على كل حال ذاكرون من ذلك ما نرى أنّ ذكره أوجب وألزم وأعون على بلوغ غرض كتابنا هذا، وبالله نستعين.
في تعرُّف الرجل عيوب نفسه
من أجل أنّ كل واحد منّا لا يمكنه منع الهوى محبةً منه لنفسه واستصواباً واستحساناً لأفعاله، وأن ينظر بعين العقل الخالصة المحضة إلى خلائقه وسيرته -لا يكاد يستبين ما فيه من المعايب والضرائب الذميمة، ومتى لم يستبين ذلك فيعرفه لم يُقلِع عنه إذ ليس يَشعُر به فضلاً عن أن يستقبحه ويعمل في الإقلاع عنه - فينبغي أن يُسند الرجل أمره في هذا إلى رجل عاقل كثير اللزوم له والكون معه، ويسأله ويضرع إليه ويؤكِّد عليه أن يُخبره بكل ما يعرفه فيه من المعايب، ويُعلمه أن ذلك أحبُ الأشياء إليه وأوقعها عنده، وأنّ المنّة عليه منه تعظم في ذلك والشكر يكثر، ويسأله أن لا يستحييه في ذلك ولا يجامله، ويعلمه أنه متى تساهل وضجع في شيء منه فقد أساء إليه وغشه واستوجب عليه اللائمة عليه. فإذا أخذ الرجل المشرف يُخبره ويُعلمه ما فيه وما ظهر وبان له منه لم يُظهر له اغتماماً ولا استخزاءً، بل اظهر له سروراً بما يستمع وتشوُّقاً إلى ما لم يستمع منه. فإن رآه في حالٍ ما قد كتمه شيئاً استحياءً منه أو قصّر في العبارة عن تقبيح ذلك أو حسنها لامه على ذلك وأظهر له اغتماماً به، وأعلمه أنه لا يحب ذلك منه ولا يريد إلاّ التصريح وإعلامه ما يراه على وجهه. فإن وجده في حال أخرى قد زاد وأسرف في تقبيح شيء رآه منه وتهجينه لم يغضبه ذلك بل حمده عليه وأظهر له بِشراً وسروراً بما رآه منه. وينبغي أن يجِّدد سؤال هذا المشرف عليه حالاً بعد حال. فإن الأخلاق والضرائب الرديّة قد تحدث بعد أن لم تكن. وينبغي أن يستخبر ويتحسس ما يقول فيه جيرانه ومعاملوه وإخوانه وبماذا يمدحونه وبماذا يعيبونه، فإن الرجل إذا سلك في هذا المعنى هذا المسلك لم يكد يخفى عليه شئ من عيوبه وإن قلّ وخفى. فإن اتّفق له ووقع عدوٌّ ومنازع مُحب لإظهار مساويه ومعايبه لم يستدرك من قَبله معرفة عيوبه، بل إظطُرَّ واُلجِئ إلى الإقلاع عنها، إن كان ممّن لنفسه مقدار وممّن يحب أن يكون خيراً فاضلاً. وقد كتب في هذا المعنى جالينوس كتاباً جعل رسمة "في الأخيار ينتفعون بأعدائهم"، فذكر فيه منافع صارت أليه من أجل عدوّ كان له. وكتب أيضاً "في تعرف الرجل عيوب نفسه" مقالةً قد ذكرنا نحن جوامعها وجملتها هنا. وفيما ذكرنا من هذا الباب كفاية وبلاغ، ومَن استعمله لم يزل كالقِدح مقوَّماً مثقَّفاً.
في العشق والإلف وجملة الكلام في اللذّة
أمّا الرجال المذكورون الكبار الهمم والأنفس فإنهم يبعدون من هذه البليّة من نفس طبائعهم وغرائزهم. وذلك أنه لا شئ أشدّ على أمثال هؤلاء من التذلُّل والخضوع والاستكانة وإظهار الفاقة والحاجة واحتمال التجني والاستطالة. فهم إذا فكروا يلزم العُشاق من هذه المعاني نفروا منه وتصابروا وأزالوا الهوى عنه وإن بُلوا به، وكذلك الذين تلزمهم أشغال وهموم بليغة اضطرارية دنيائية أو دينية. فأما الخَنِثون من الرجال والغَزِلون والفُرّاغ والمُترفون والمؤثِرون للشهوات الذين لا يهمهم سواها ولا يريدون من الدنيا إلاّ إصابتها، ويرون فَوتها فَوتاً وأسفاً، وما لم يقدروا عليه منها حسرةً وشقاءً، فلا يكادون يتخلصون من هذه البلية لا سيما إن أكثروا النظر في قصص العُشاق ورواية الرقيق الغزِل من الشعر وسماع الشجي من الألحان والغناء. فلنقل الآن في الاحتراس من هذا العارض والتنبيه على مَخاتله ومكامنه بقدر ما يليق بغرض كتابنا هذا. ونقدِّم قبل ذلك كلاماً نافعاً مُعيناً على بلوغ غرض ما مرّ من هذا الكتاب وما يأتي بعده، وهو الكلام في اللذّة.
فنقول: إن اللذة ليست بشيء سوى إعادة ما أخرجه المؤذي عن حالته إلى حالته التي كان عليها. كرجل خرج من موضع كنين ظليل إلى صحراء ثم سار في شمس صيفية حتى مسّه الحر ثم عاد إلى مكانه ذلك، فإنه لا يزال يستلذ ذلك المكان حتى يعود بدنهُ إلى حالته الأولى، ثم يفقد ذلك الاستلذاذ مع عَود بدنه إلى الحالة الأولى، وتكون شدّة التذاذه بهذا المكان بمقدار شدّة إبلاغ الحرّ إليه وسرعة هذا المكان في تبريده. وبهذا المعنى حدّ الفلاسفة الطبيعيون اللذّة، فإنّ حدّ اللّذة عندهم هو رجوع إلى الطبيعة. ولأن الأذى والخروج عن الطبيعة ربما حدث قليلاً في زمان طويل، ثم حدث بعقبه رجوع إلى الطبيعة دفعةً في زمان قصير صار في مثل هذه الحال يفوتنا الحسُّ بالمؤذي ويتضاعف بيان الإحساس بالرجوع إلى الطبيعة، فنسمي هذه الحال لذةً. ويظّن بها مَن لا رياضة له أنها حدثت من غير أذى تقدمها، ويتصورها مفردةً خالصةً بريةً من الأذى. وليست الحال على الحقيقة كذلك بل ليس يمكن أن تكون لذّة بتّةً إلا بمقدار ما تقدمها من أذى الخروج عن الطبيعة. فإنه بمقدار أذى الجوع والعطش يكون بالالتذاذ بالطعام والشراب، حتى إذا عاد الجائع والعطشان إلى حالته الأولى لم يكن شئ أبلغ من عذابه من إكراهه على تناولهما بعد أن كانا ألذّ الأشياء عنده وأحبها إليه. وكذلك الحال في سائر الملاذّ فإن هذا الحد بالجملة لازمٌ لها ومحتوٍ عليها، إلا أن منها ما نحتاج في تبيين ذلك منه إلى كلام أدقّ وألطف وأطول من هذا. وقد شرحنا هذا في مقالة كتبناها "في مائية اللذة"، وفي هذا المقدار الذي ذكرناه هاهنا كفاية لما نحتاج إليه. وأكثر المائلين مع اللذّة المنقادين لها هم الذين لم يعرفوها على الحقيقة ولم يتصوروا منها إلا الحالة الثانية، أعني التي من مبدأ انقضاء فعل المؤذي إلى استكمال الرجوع إلى الحالة الأولى. ومن أجل ذلك أحبوها وتمَّنوا أن لا يخلوا في حال منها، ولم يعلموا أنّ ذلك غير ممكن لأنها حالة لا تكون ولا تُعرَف إلا بعد تقدُّم الأولى لها.
وأقول أنّ اللذّة التي يتصوروها العُشاق وسائرُ مَن كلِفَ بشيء وأُغرمَ به - كالعُشاق للترؤُّس والتملُّك وسائرِ الأمور التي يفرط ويتمكن حبها من نفوس بعض الناس حتى لا يتمنوا إلا إصابتها ولا يروا العيش إلاّ مع نيلها - عند تصوُّرهم نيل مرادهم عظيمةٌ مجاوزة للمقدار جداً. وذلك أنهم إنما يتصورون إصابة المطلوب ونيله مع عظم ذلك في أنفسهم من غير أن يخطر ببالهم الحالةُ الأولى التي هي كالطريق والمسلك إلى نيل مطلوبهم. ولو فكروا ونظروا في وعورة هذا الطريق وخشونته وصعوبته ومخاطره ومهاويه ومهالكه لمرّ عليهم ما حلا وعظُم ما صغر عندهم في جنب ما يحتاجون إلى مقاساته ومكادحته.
وإذ قد ذكرنا جملة مائية اللذّة وأوضحنا من أين غلط مَن تصُرها محضةً بريةً من الألم والأذى فإنا عائدون إلى كلامنا ومنبِّهون على مساوئ هذا العارض أعني العشق وخساسته. فنقول: إن العُشّاق يجاوزون حدّ البهائم في عدم ملكة النفس وزمّ الهوى وفي الانقياد للشهوات. وذلك أنهم لم يرضوا أن يصيبوا هذه الشهوة، أعني لذّ الباه - على أنها من أسمج الشهوات وأقبحها عند النفس الناطقة التي هي الإنسان على الحقيقة - من أيّ موضع يمكن إصابتها منه، حتى أرادوها من موضع مّا بعينه فضمّوا شهوةً إلى شهوة وانقادوا وذّلوا للهوى ذلاً على ذلّ وازدادوا له عبوديةً إلى عبوديّة. والبهيمة لا تصير من هذا الباب إلى هذا الحدّ ولا تبلغه، ولكنها تصيب منه بقدر ما لها في الطبع مما تطرح به عنها ألم المؤذي المَّهيج لها عليه لا غير، ثم تصير إلى الراحة الكاملة منه. وهؤلاء لمّا لم يقتصروا على المقدار البهيمي من الانقياد للطباع، بل استعانوا بالعقل - الذي فضّلهم الله على البهائم وأعطاهم إيّاه ليروا مساوئ الهوى ويزمّوه ويملكوه - في التسلُّق على لطيف الشهوات وخفّيها والتحُّيز لها والتّفوق فيها، وجب عليهم وحقَّ لهم ألاّ يبلغوا منها إلى غاية ولا يصيروا منها إلى راحة، ولا يزالوا متأذّين بكثرة البواعث عليها ومتحسِّرين على كثرة الفائت منها غير مغتبطين ولا راضين - لنزوع أنفسهم عنها وتعلُّق أمانيهم بما فوقها وبما لا نهاية له منها - بما نالوه أيضاً وقدروا عليه منها. ونقول أيضاً: إن العُشّاق مع طاعتهم للهوى وإيثارهم اللذّة وتعبدَّهم لها يحزنون من حيث يظنون أنهم يفرحون، ويألمون من حيث يظنون أنهم يلذّون. وذلك أنهم لا ينالون من ملاذهم شيئاً ولا يصلون إليه إلاّ بعد أن يمسّهم الهمّ والجهد ويأخذ منهم ويبلغ إليهم. وربما لم يزالوا من ذلك في كُرَب منُصِبة وغُصَصٍ متصلة من غير نيل مطلوبٍ بتّةً. والكثير منهم يصير لِدوام السهر والهم وفقد الغذاء إلى الجنون والوسواس وإلى الدِقّ والذبول. فإذا هم وقعوا من حِبال اللذة وشِباكها في الرديء والمكروه، وأدتّهم عواقبها إلى غاية الشقاء والتهلكة. وأمّا الذين ظنّوا أنهم ينالون لذّة العشق كَمَلاّ ويصيبونه مّمن ملكوه وقدروا عليه فقد غلطوا وأخطئوا خطاً بيّناً. وذلك أنّ اللذّة إنما تكون إذا نيلة بمقدار بلاغ ألم المؤذي الباعث عليها الداعي إليها، ومَن ملك شيئاً وقدر عليه ضعف فيه هذا الباعث الداعي وهدأ وسكن سريعاً. وقد قيل قولاً حقّاً صدقاً إنّ كل موجود مملوك وكل ممنوع مطلوب ونقول أيضا: إن مفارقة المحبوب أمر لا بد منه اضطرارا بالموت، وإن سلم من سائر حوادث الدنيا وعوارضها المبددة للشمل المفرقة بين الأحبة. وإذا كان لا بد من إساغة هذه الغصة وتجرع هذه المرارة فإن تقديمها والراحة منها أصلح من تأخيرها والانتظار لها، لأن ما لا بد من وقوعه متى قُدّم أُزِيحَ مؤونة الخوف منه مدة تأخيره. وأيضا فإن منع النفس من محبوبها قبل أن يستحكم حُبّه ويرسخ فيها ويستولي عليها أيسر وأسهل. وأيضا فإن العشق متى انضم إليه الإلف عسر النزوع عنه والخروج منه، فإن بلية الإلف ليست بدون بلية العشق، بل لو قال قائل إنه أوكد وأبلغ منه لم يكن مخطئا، ومتى قصرت مدة العشق وقل فيه لقاء المحبوب كان أحرى أن لا يخالطه ويعاونه الإلف. والواجب في حكم العقل من هذا الباب أيضا المبادرة في منع النفس وزمِّها عن العشق قبل وقوعها فيه، وفطمها منه إذا وقعت قبل استحكامه فيها. وهذه الحجة يقال إن فلاطن الحكيم احتج بها على تلميذ له بلى بحب جارية فأخل بمركزه من مجلس مدارس فلاطن. فأمر أن يطلب ويؤتى به، فلما مثل بين يديه قال أخبرني يا فلان هل تشك في انه لا بد لك من مفارقة حبتك هذه يوما ما؟ قال ما أشك في ذلك. فقال له فلاطن فاجعل تلك المرارة المتجرعة في ذلك اليوم في هذا اليوم، قال ما أشك في ذلك. فقال له فلاطن فاجعل تلك المرارة المتجرعة في ذلك اليوم، وأزح ما بينهما من خوف المنتظر الباقي بحاله الذي لابدّ من مجيئه وصعوبة معالجة ذلك بعد الاستحكام وانضمام الإلف إليه وعَضْدِه له. فيقال إنّ التلميذ قال لفلاطن إنّ ما تقول أيها السيد الحكيم حقٌ، لكني أجدُ انتظاري له سلوةً بمرور الأيام عنّي أخفُّ عليَّ. فقال له فلاطن وكيف وثقت بسلوة الأيام ولم تَخَفْ إلفها، ولم أمنت أن تأتيك الحالة المفرِّقة قبل السلوة وبعد الاستحكام، فتشتدّ بك الغُصّة وتتضاعف عليك المرارة. فيقال إن ذلك الرجل سجد في تلك الساعة لفلاطن وشكره ودعا له وأثنى عليه، ولم يعاود شيئاً مما كان فيه ولم يَظهر منه حزن ولا شوق، ولم يزل بعد ذلك لازماً لمجالس فلاطن غيرَ مُخلٍّ بها بتّةً. ويقال إنّ فلاطن أقبل بعد فراغه من هذا الكلام على وجوه تلامذته فلامهم وعذلهم في تركهم وإطلاقهم هذا الرجلَ وصَرْفَ كل همّته إلى سائر أبواب الفلسفة قبل إصلاح نفسه الشهوانية وقمعها وتذليلها للنفس الناطقة.
ولأن قوماً رُوعْناً يعاندون ويناصبون الفلاسفة في هذا المعنى بكلام سخيف ركيك كسخافتهم وركاكتهم - وهؤلاء هم الموسومون بالظرف والأدب - فإنّا نذكر ما يأتون به في هذا المعنى ونقول فيه من بعده. إنّ هؤلاء القوم يقولون إنّ العشق إنما يعتاده الطبائعُ الرقيقة والأذهان اللطيفة، وإنه يدعو إلى النظافة واللباقة والزينة والهيئة. ويُشيعون هذا ونحوه من كلامهم بالغزل من الشعر البليغ في هذا المعنى، ويحتجّون بمن عشق من الأدباء والشعراء والسراة والرؤساء ويتخطونهم إلى الأنبياء. ونحن نقول: إنّ رقّة الطبع ولطافة الذهن وصفاءه يُعرَفان ويُعتبران بإشراف أصحابهما على الأمور الغامضة البعيدة والعلوم اللطيفة الدقيقة وتبيين الأشياء المشكلة الملتبسة واستخراج الصناعات المُجدِيَة النافعة.
ونحن نجد هذه الأمور مع الفلاسفة فقط، ونرى العشق لا يعتادهم ويعتاد اعتياداً كثيراً دائماً أجلاف الأعراب والأكراد والأعلاج والأنباط. ونجد أيضاً من الأمر العامّ الكلّي أنه ليست أمة من الأمم أرقّ فطنةً وأظهر حكمةً من اليونانيين، ونجد العشق في جملتهم أقلّ ممّا في جملة سائر الأمم. وهذا يوجِب ضدَّ ما ادّعوه، أعني أنه يوجب أن يكون العشق إنما يعتاد أصحابَ الطبائع الغليظة والأذهان البليدة، ومَن قلّ فكره ونظره ورويته بادر إلى الهجوم على ما دعته إليه نفسه ومالت إليه شهوته. وأمّا احتجاجهم بكثرة مَن عشق من الأدباء والشعراء والسراة والرؤساء فإنا نقول: إنّ السروَ والرياسة والشعر والفصاحة ليست ممّا لا يوجد أبداً إلاّ مع كمال العقل والحكمة، وإذا كان الأمر كذلك أمكن أن يكون العُشاق من هؤلاء من النقص في عقولهم وحكمتهم. وهؤلاء القوم لجهلهم ورعونتهم يحسبون أنّ العلم والحكمة إنما هو النحو والشعر والفصاحة والبلاغة، ولا يعلمون أنّ الحكماء لا يَعُدّون ولا واحداً من هذه حكمةً ولا الحاذق بها حكيماً، بل الحكم عندهم من عرف شروط البرهان وقوانينه واستدراك وبلغ من العلم الرياضي والطبيعي والعلم الإلهي مقدار ما في وسع الإنسان بلوغُه. ولقد شهدت ذات يوم رجلاً من متحذلقيهم عند بعض مشايخنا بمدينة السلام، وكان لهذا الشيخ مع فلسفته حظّ وافر من المعرفة بالنحو واللغة والشعر، وهو يجاريه وينشده ويبذخ ويشمخ في خلال ذلك بأنفه ويُطنب ويبالغ في مدح أهل صناعته ويرذل مَن سواهم، والشيخ في كل ذلك يحتمله معرفةً منه بجهله وعُجبه ويتبسّم إلى أن قال فيما قال: هذا والله العلم وما سواه ريح، فقال له الشيخ يا بنيّ هذا علم مَن لا علم له ويفرح به من لا عقل له. ثم أقبل عليّ وقال سل فتانا هذا عن شيء من مبادئ العلوم الاظطرارية، فإنه ممّن يرى أنّ مَن مهر في اللغة يمكنه الجواب عن جميع ما يُسئل عنه. فقلت خبَّرني عن العلوم أَظطرارية هي أم اصطلاحية؟ ولم أتمم التقسيم على تعمُّد، فبادر فقال العلوم كلها اصطلاحيه. وذلك أنه كان سمع أصحابنا يعيرون هذه العصابة أنّ علمهم اصطلاحي، فأحب أن يعيهم بمثل ما عابوه جهلاً منه بما لهم دونه في هذا الباب.
فقلت له فمَن علم أنّ القمر ينكسف ليلة كذا وكذا، وأن السقمونيا يُطلق البطن متى أُخذ، وأن المرداسنج يذهب بحموضة الخلّ متى سُحق وطُرح فيه إنما صحّ له علم ذلك من اصطلاح الناس عليه؟ فقال لا. فقلت فمن أين عُلم ذلك؟ فلم يكن فيه من الفضل ما يبين عمّا به نحوتُ. ثم قال فإني أقول إنها كلها اضطرارية، ظنّاً منه وحسباناً أنه يتهيأ له أن يُدرج النحو في العلوم الاضطرارية. فقلت له خبِّرني عمّن عُلم أنّ المنادى بالنداء المفرد مرفوع وأن المنادى بالنداء المضاف منصوب، أعُلم أمراً اضطراريّاً طبيعياً أم شيئاً مصطلحاً باجتماع من بعض الناس عليه دون بعض؟ فلجلج بأشياء يروم بها أن يُثبت أنّ هذا الأمر اضطراري ممّا كان يسمعه من أستاذيه، فأقبلت أُريه تداعيه وتهافُتَه مع ما لحقه من استحياءٍ وخجل شديد واغتنام. وأقبل الشيخ يتضاحك ويقول له ذُق يا بنيّ طعم العلم الذي هو على الحقيقة علم. وإنما ذكرنا من هذه القصّة ما ذكرنا ليكون أيضاً من بعض المنبِّهات والدواعي إلى الأمر الأفضل، إذ ليس لنا غرض في هذا الكتاب إلاّ ذاك ولسنا نقصد - بما مرّ من كلامنا هذا من الاستجهال والاستنقاص - لِجميع من عُني بالنحو والعربيّة واشتغل بهما وأخذ منهما، فإن فيهم مَن قد جمع الله له إلى ذلك حظّاً وافراً من العلوم، بل للجهّالِ من هؤلاء الذين لا يرون أنّ علماً موجود سواهما ولا أنّ أحداً يستحق أن يسمَّى عالماً إلاّ بهما وقد بقي علينا من حجاج القوم شئ لم نقل فيه قولاً، وهو احتجاجهم لتحسين العشق بالأنبياء وما بُلُوا به منه. فنقول: إنه ليس من أحد يستجيز أن يُعَد العشق منقبةً من مناقب الأنبياء ولا فضيلةً من فضائلهم ولا أنه شئ آثروه واستحسنوه، بل إنما يُعَدّ هفوةً وزلةً من هفواتهم وزلاّتهم. وإذا كان ذلك كذلك فليس لتحسينه وتزيينه ومدحه وترويجه بهم وجه بتّةً، لأنه إنما ينبغي لنا أن نحث أنفسنا ونبعثها من أفعال الرجال الفاضلين على ما رضوه لأنفسهم واستحسنوه لها وأحبوا أن يُقتدى بهم فيه، لا على هفواتهم وزلاّتهم وما تابوا منه وندموا عليه وودّوا أن لا يكون ذلك جرى عليهم وكان منهم. فأما قولهم إنّ العشق يدعو إلى النظافة واللباقة والهيئة والزينة، فما يُصنع بجمال الجسد مع قبح النفس، وهل يحتاج إلى الجمال الجسداني ويجتهد فيه إلاّ النساء وذوو الخُنث من الرجال؟ ويقال إن رجلاً دعا بعض الحكماء إلى منزله، وكان كل شئ له من آلة المنزل على غاية السرور والحسن، وكان الرجل في نفسه على غاية الجهل والبله والفدامة. ويقال إنّ ذلك الحكيم تأمل كل شئ في منزله ثم إنه بصق على الرجل نفسه. فلما استشاط وغضب من ذلك قال له لا تغضب، فإني تأمّلت جميع ما في منزلك وتفقّدته فلم أر فيه أسمج ولا أرذل من نفسك، فجعلتها موضعاً للبصاق باستحقاق منها لذلك. ويقال إنّ ذلك الرجل بعد ذلك استخّفّ بما كان فيه وحرص على العلم والنظر. ولأنا قد ذكرنا فيما مر من كلامنا قُبَيلُ الإلفَ فإنا قائلون في هائيته والاحتراس منه بعض القول، فنقول: إنّ الإلف هو ما يحدث في النفس عن طول الصحبة من كراهية مفارقة المصحوب، وهي أيضاً بليّة عظيمة تنمى وتزداد على الأيام ولا يُحَس بها إلاّ عند مفارقة المصحوب، ثم يظهر منها حينئذ دفعةً أمرٌ مؤذٍ للنفس جداً. وهذا العارض يعرض للبهائم أيضاً إلاّ أنه في بعضها أوكد منه في البعض. والاحتراس منه يكون بالتعرُّض لمفارقة المصحوب حالاً بعد الحال، وأن لا يُنسى ذلك ويُفعل البتّة بل تُدرَّج نفسه إليه وتُمرَّن عليه. وقد بيّنّا من هذا الباب ما فيه كفاية، ونحن الآن قائلون في العُجب.
في العُجب
أقول: إنه من أجل محبّة كل إنسان لنفسه يكون استحسانه للحَسَن منها فوق حقّه واستقباحه للقبيح منها دون حقّه، ويكون استقباحه للقبيح واستحسانه للحسن من غيره - إذ كان بريّاً من حُبّه وبُغضّه - بمقدار حقّه، لأنّ عقله حينئذ صافٍ لا يشوبه ولا يجاذبه الهوى. ومن أجل ما ذكرنا فإنه إذا كانت للإنسان أدنى فضيلةٍ عَظُمَت عند نفسه وأحبّ أن يُمدَح عليها فوق استحقاقه. وإذا تأكدت فيه هذه الحالة صار عُجباً، ولا سيمّا إن وجد قوماً يساعدونه على ذلك ويبلغون من تزكيته ومدحه ما يحب. ومن بلايا العُجب أنه يؤدي إلى النقص في الأمر الذي يقع به العُجب، لأنّ المُعجب لا يروم التزيُّد ولا الاقتناء والاقتباس من غيره في الباب الذي منه يُعجَب بنفسه. لأنّ المُعجَب بفرسه لا يروم أن يستبدل به ما هو أفرهُ منه لأنه لا يرى أنّ فرساً أفرهُ منه، والمُعجب بعمله لا يتزيَّد منه لأنه لا يرى أنّ فيه مزيداً. ومَن لم يستزد من شئٍ ما نقص لا محالة وتخلّف عن رتبة نظرائه وأمثاله، لأنّ هؤلاء - إذا كانوا غير مُعجبين - لم يزالوا مستزيدين ولم يزالوا لذلك متزيِّدين مترقِّين، فلا يلبثوا أن يجاوزوا المُعجب ولا يلبث المُعجب أن يتخلّف عنهم. وممّا يُدفع به المُعجب أن يَكِلَ الرجلُ اعتبارَ مساويه ومحاسنه إلى غيره على ما ذكرنا قبلُ حيث ذكرنا تعرُّف الرجل عيوب نفسه، وأن لا يعتبر ولا يقيس نفس بقومٍ أخساء أدنياء ليس لهم حظ وافر من الشيء الذي أُعجب به من نفسه، أو يكون في بلدٍ هذه حالةٌ أهله. فأنه مَن احترس من هذين البابين لم يزل يَرِدُ عليه كلَّ يوم ما يكون به إلى تنقُّص نفسه أمْيَلَ منه إلى العُجب بها. وفي الجملة فإنه ينبغي أن لا تكبر وتعظم نفسه عنده حتى يجاوز مقدار نظرائه عند غيره، ولا تصغر ولا تقل حتى ينحط عنهم أو عمّن هو دونه ودونهم عند غيره. فإنه إذا فعل ذلك وقوم نفسه عليه كان برياً من زهو العُجب وخسة الدناءة، وسماه الناس العارف بقدر نفسه. وفيما ذكرنا أيضاً في هذا الباب كفاية، فلنقل الآن في الحسد.
في الحسد
أقول: إن الحسد أحد العوارض الرديّة ويتولد من اجتماع البخل والشره في النفس. والمتكلمون في إصلاح الأخلاق يسمون الشرير مَن يلتذّ طباعاً مَضارَّ تقع بالناس ويكره ما وقع بموافقتهم وإن كانوا لم يَتِرُوه ولم يَسوؤه، كما أنهم يسمون الخير مَن أحبّ وإلتذّ ما وقع بوفاق الناس ونفعهم. والحسد شرّ من البخل لأن البخيل إنما لا يحب ولا يرى أن ينيل أحداً شيئاً مما يملكه ويحويه، والحسود يحب أن لا ينال أحد خيرً بتّةً ولو مما لا يملكه، وهو داء من أدواء النفس عظيم الأذى لها. ومما يدفع به أن يتأمل العاقل الحسد، فأنه سيجد له من رسم الشرير حظاً وافراً إذ كان الحسود يُرسم بأنه كاره لِما وقع بوفاق مَن لم يَترْه ولم يُسِئْ به. وهذا شطرٌ من حدّ الشرَّير، الشرَّير مستحق للمقت من البارئ ومن الناس. أما من البارئ فلأنه مضادّ له في إرادته إذ هو عزّ اسمه المفضَّلُ على الكل المريدُ الخيرَ للكل. وأما من الناس فلأنه مُبغض ظالم لهم، فإن مَن أحب وقوع المكروه بإنسان ما أو لم يحب وصول خير إليه مبغض له. فإن كان هذا الإنسان مّمّن لم يَتِرْه ولم يُسِئْ به فإنه مع ذلك ظالم له. وأيضاً فإن المحسود لم يُزِلْ عن الحاسد شيئاً مّمّا هو في يديه ولا منعه من بلوغ شئ كان يقدَر عليه ولا استعان به على شئٍ من أمره. وإذا كان ذلك كذلك فما هو -أعني المحسود - إلاّ بمنزلة سائر من نال خيراً وبلغ أمنيته من الناس الغائبين عن الحاسد. فكيف لا يحسد من بالهند والصين؟ فإن كان لا يحسدهم من اجل غيبتهم عنه فليتصوّرهم بأحوالهم وما ينقلبون فيه من نعيمهم. فإن كان حُمقاً أو جنوناً أن يحزن لما نال هؤلاء وبلغوا من أمانيهم فإن حُمقاً مثله الحُزنُ والاغتمام لما نال من بحضرته إذ كانوا بمنزلة الغُيَّب عنه في أنهم لم يسلبوه شيئاً مما في يديه ولا منعوه بلوغ شئ كان يقدر عليه ولا استعانوا على أمر من أمورهم به. وليس بينهم وبين الغُيّب عنه فرق إلا في مشاهدة الحاسد أحوالهم التي يمكن تصوُّر مثلها من الغُيّب عنه ويعلم ويستيقن أنهم منها في مثل ما هم فيه.
وقد يغلط بعض الناس في حد الحسد حتى إنهم يَسِمون بالحسد قوماً إنما يكرهون الخير لمَن عليهم منهم في إصابتهم ذلك بعض المضار والمؤن. وليس ينبغي أن يسمَّى ولا واحدٌ من هؤلاء حاسداً، بل ينبغي أن يسمى الحاسد مطلقاً من اغتم من خير يناله غيره من حيث لا مضرّة عليه منه البتّة، ويسمى بليغ الحسد من اغتم من خيرٍ يناله غيره وإن كان له في ذلك نفع ما. فأما إذا جاءت المؤن والمضار فإنها تحدث في النفس عداوةً بمقدارها لا حسداً. ومثل هذا من التحاسد لا يكاد يكون إلا بين الأقرباء والمعاشرين والمعارف. فإنا نرى الرجل الغريب يملك أهل بلدٍ ما ولا يكادون يجدون في أنفسهم كراهةً لذلك، ثم يملكهم رجل من بلدهم فلا يكاد أن يتخلص ولا واحد منهم من كراهيته لذلك، هذا على أنه ربما كان هذا الرجل المالك - أعني البلديّ- أرأف بهم وأنظر إليهم من المالك الغريب. وإنما يؤُتَى الناسُ في هذا الباب من فرط محبتهم لأنفسهم، وذلك أن كل واحد منهم من أجل حُبه لنفسه يحب أن يكون سابقاً إلى المراتب المرغوب فيها غير مسبوق إليها فإذا هم رأوا من كان بالأمس معهم اليوم سابقاً لهم مقدَّماً عليهم اغتموا لذلك وصعب واشتدّ عليهم سَبقُه إيّاهم إليها، ولم يُرضِهم منه تعطُّفُه عليهم ولا إحسانه إليهم، لأن أنفسهم متعلِّقة بالغاية مما صار إليه هذا السابق لا غير لا يرضيهم سواه ولا يستريحون دونه. وأما المالك الغريب فمن أجل أنهم لم يشاهدوا حالته الأولى لا يتصورون كمالَ سَبِقه لهم وفضله عليهم فيكون ذلك أقلَّ لغمِّهم وأسفهم. وقد ينبغي أن يُرجع في مثل هذا إلى العقل ويُتَأمَّل في هذا الأمر ما أقول.
أقول: إنه ليس لَحَنقِِ الحاسد وغيظه وبُغضه لهذا الرجل القريب السابق له وجهٌ في العدل بتةً، وذلك أنه لم يمنع المسبوقَ من المبادرة إلى المطلوب وإن حصّله وحَظِيَ به دونه. وليس الحظُّ الذي ناله هذا السابقُ شيئاً كان الحاسدُ أحقَّ به أو أحوجَ إليه، فلا يُبغضْه إذا ولا يحنقْ عليه بل ليحنق على جَدَّه أو على تراخيه، فإن أحدهما هو الذي حرمه وأقعده عن بلوغ أمله. مع أنه إذا كان هذا السابق أخاً أو ابن عمّ أو قريباً أو معرفةً أو بلديّاً كان أصلحَ للحاسد وكان أرجى لخيره وآمَنَ مِن شرِّه، إذ بينهما وُصلة التختُّن وهي وُصلة طبيعية وكيده وأيضاً فإنه إذا كان لا بد أن يكون في الناس الرؤساءُ والملوك والمُثْرُون والمُكثِرون ولم يكن الحاسدُ ممّن يؤمِّل ويرجو أن يصير ما هو لهم إليه أو إلى مَن صار إليه انتفع هو به فليس لكراهيته أن يبقى عليه وجهٌ في العقل بتّةً، لأنه سواء عليه بقى فيهم أو صار إلى غيرهم ممّن حالهُ في عدم انتفاعه بهم حالهُ وأيضاً فنقول: إنّ العاقل قد يزمُّ ببصيرة نفسه الناطقة وقوة نفسه الغضبيّة نفسَه البهيمية حتى يرعها من إصابة الأشياء اللذيذة الشهيّة عمّا لا شهوة ولا لذّة فيه، وفيه مع ذلك مضرّة النفس والبدن جميعاً. وأقول: إنّ الحسد ممّا لا لذّةَ فيه، وإن كان فيه منها شئ فإنه أقلّ كثيراً من سائر الأشياء من اللذّات، وهو مُضر بالنفس والجسد. أمّا بالنفس فلأنه يُذهلها ويُعزب فكرها ويَشغلها حتى لا تفرغ للتصرُّف فيما يعود نفعُه على الجسد وعليها لِما يعرض معه للنفس من العوارض الردّيئة، مثل طول الحزن والهّم والفكر. وأمّا بالجسد فلأنه يعرض له عند حدوث هذه الأعراض للنفس طولُ السهر وسوءُ الاغتذاء، ويُعقب ذلك رداءةَ اللون وسوءَ السَحنَة وفسادَ المزاج. وإذا كان العاقل يزُمّ بعقله الهوى - المقرَّبَ إليه الشهوات اللذيذةَ بعد أن تكون ممّا يُعقب مضرةً - فأولى به وأولى أن يجتهد في محوِ هذا العارض عن نفسه ونسيانه ولإضراب عنه وترك الفكر فيه متى خطر بباله. وأيضاً فإن الحسد نِعْمَ العون والمنتقِمُ من الحاسد والمحسود، وذلك أنه يُديم همَّه وغمَّه ويذُهِل عقله ويعذِّب جسده ويوُهِن بأشغال نفسه وإضعاف جسده كيدَه للمحسود وسعيه عليه إن دام ذلك. فأيُّ رأي هو أولى بالتسفيه والترذيل من الذي لا يجلب على صاحبه إلا ضرراً، وأيُّ سِلاح أحقُّ وأَولى بالاطّراح من الذي هو جُنّة للعدوّ وجارح للحامل؟ وأيضاً فإنّ ممّا يمحو الحسدَ عن النفس ويُسهِّل ويُطيب لها الإقلاعَ عنه أن يتأمّل العاقلُ أحوالَ الناس - ترقِّيهم في المراتب ووصولهم إلى المطالب - وأحوالهم مما صاروا إليه من هذين البابين، ويُجيدَ التثبُّتَ فيه على ما نحن ذاكروه هاهنا، فإنه سيَهجُم منه على أنّ حالة المحسود عند نفسه خلافُها عند الحاسد، وأنّ يتصورّه الحاسدُ من عِظَمها وجلالتها ونهايةِ غبطة المحسود وتمتُّعه بها ليس كذلك. أقول: إنّ الإنسان لا يزال يستعظم الحالةَ ويستجلّها ويودّ ويتمنى بلوغَها والوصول إليها، ويرى بل لا يشك أنّ الذين قد نالوها وبلغوها هم في غاية الاغتباط والاستمتاع بها، حتى إذا بلغها ونالها لم يفرح ولم يُسَرّ بها إلاّ مُدَيدةً يسيرةً بقدر ما يستقر فيها ويتمكن منها ويُعرف بها، ويكون هذه المُدَيدةَ عند نفسه مسعوداً مغتبطاً بها، حتى إذا حصلت له هذه الحالةُ - المتمنَّاةُ كانت - واستحكم كونُه فيها وملكه لها ومعرفةُ الناس له بها سَمَتْ نفسُه إلى ما هو فوقها وتعلّقت أمنيته بما هو أعلى منها، فاستقل واسترذل حالتَه التي هو فيها التي قد كانت من قبلُ غايَته وأملَه، وصار بين هّم وخوفٍ: أمّا الخوف فمن النزول عن الدرجة التي نالها وحصّلها، وأمّا الهّم فبالتي يقدِّر بلوغها. فلا يزال متقنِّطاً لها متنغِّصا بها زارياً عليها، مُتعبَ الفكر والجسد في إعمال الحيلة للتنقُّل عنها والترقَّي منها إلى ما سواها، ثم تكون حالته في الثانية كذلك وفي الثالثة إن بلغها وفي كل ما نال ووصل إليه منها. وإذا كان الأمر كذلك فيحق على العاقل أن يحسد أحداً على فضل من دُنيا ناله ممّا يستغنى عنه في إقامة العيش، وأن لا يظن أنّ أصحاب الفضل فيها والإكثار منها لهم من فضل الراحة واللذّة بحسب ما عندهم من فضل عُروض الدنيا. وذلك أنّ هؤلاء لِمطاولة هذه الحال ودوامها يصيرون - بعد الراحة واللذة ودوامها - إلى أن لا يلتذّوها، لأنها تصير عندهم بمنزلة الشيء الطبيعي الاضطراري في بقاء العيش، فيقرب من أجل ذلك التذاذُهم بها من التذاذ كل ذي حالة بحالته المعتادة. وكذلك تكون قضيّتهم في قلّة الراحة، وذلك أنه من أجل أنهم لا يزالون مُجدِّين منكمشين في الترقِّي والعلو إلى ما فوقهم تَقِلُّ راحتهم، حتى إنها ربما كانت أقلَّ من راحة مَن هو دونهم، ولا ربما بل هي في أكثر الأمور دائماً أبداً كذلك. فإذا لاحظ العاقل هذه المعاني وتأملها آخذاً فيها بعقله طارحاً لهواه عَلِمَ أنّ الغاية التي يمكن بلوغها من لذاذة العيش وراحته هي الكفاف، وأن ما فوقه من أحوال المعاش مقارب في ذلك بعضه لبعض، بل الكفاف دائماً فضلُ الراحة عليها. فأيُّ وجهٍ للتحاسد إلا الجهل بها وأتباع الهوى دون العقل فيها. وفيما ذكرنا من هذا الباب أيضاً كفاية، فلنقل الآن في الغضبرون - بعد الراحة واللذة ودوامها - إلى أن لا يلتذّوها، لأنها تصير عندهم بمنزلة الشيء الطبيعي الاضطراري في بقاء العيش، فيقرب من أجل ذلك التذاذُهم بها من التذاذ كل ذي حالة بحالته المعتادة. وكذلك تكون قضيّتهم في قلّة الراحة، وذلك أنه من أجل أنهم لا يزالون مُجدِّين منكمشين في الترقِّي والعلو إلى ما فوقهم تَقِلُّ راحتهم، حتى إنها ربما كانت أقلَّ من راحة مَن هو دونهم، ولا ربما بل هي في أكثر الأمور دائماً أبداً كذلك. فإذا لاحظ العاقل هذه المعاني وتأملها آخذاً فيها بعقله طارحاً لهواه عَلِمَ أنّ الغاية التي يمكن بلوغها من لذاذة العيش وراحته هي الكفاف، وأن ما فوقه من أحوال المعاش مقارب في ذلك بعضه لبعض، بل الكفاف دائماً فضلُ الراحة عليها. فأيُّ وجهٍ للتحاسد إلا الجهل بها وأتباع الهوى دون العقل فيها. وفيما ذكرنا من هذا الباب أيضاً كفاية، فلنقل الآن في الغضب.
في دفع الغضب
إنّ الغضب جُعل في الحيوان ليكون له به انتقامٌ من المؤذي. وهذا العارض إذا أفرط وجاوز حدَّه حتى يُفقَد معه العقل فربما كانت نكايته في الغضب وإبلاغُه إليه المضرةَ أشدَّ وأكثر منها في المغضوب عليه. ومن أجل ذلك ينبغي للعاقل أن يُكثِر تذكُّرَ أحوال مَن أدَّى به غضبه إلى أمور مكروهة في عاجل الأمر وآجله، ويأخذ نفسه بتصورها في حال غضبه. فإن كثيراً ممن يغضب ربما لكم ولطم ونطح، فجلب بذلك من الألم على نفسه أكثر مما نال به من المغضوب عليه. ولقد رأيت من لكم رجلاً على فكَّه فكسر أصابعه حتى مكث يعالجها اشهُراً، ولم ينل الملكوم كثيرُ أذىً. ورأيت من استشاط وصاح فنفث الدم مكانه، وأدَّى به ذلك إلى السِلَّ وصار سبب موته. وبَلَغنا أخبارُ أُناس نالوا أهليهم وأولادهم ومن يعزُّ عليهم في وقت غضبهم بما طالت ندامتهم عليه، وربما لم يستدركوه آخر عمرهم. وقد ذكر جالينوس أن والدته كانت تثب بفمها على القفل فتعضهُ إذا تعسر عليها فتحهُ. ولعمري إنه ليس بين من فقد الفكر والروية في حال غضبه وبين المجنون كبير فرق. فإن الإنسان إذا أكثر تذكُّر أمثال هذه الأحوال في حال سلامته كان أحرى أن يتصورها في وقت غضبه. وينبغي أن يعلم أن الذين كان منهم مثل هذه الأفعال القبيحة في وقت غضبهم إنما أتوا من فقد عقولهم في ذلك الوقت، فيأخذ نفسه بأن لا يكون منه في وقت غضبه فعل إلا بعد الفكر والروية فيه، لئلا يِنَكى نفسه من حيث يروم إنكاء غيره، ولا يشارك البهائم في إطلاق الفعل من غير روية. وينبغي أن يكون في وقت المعاقبة بريا من أربع خلال: الكِبَر والبُغُض للمعاقَب ومن ضِدّي هذين، فإن الأولين يدعوان إلى أن يكون الانتقام والعقوبة مجاوزين لمقدار الجناية، والآخرين إلى أن يكونا مقصرين عنه. وإذا أخطر العاقل بباله هذه المعاني وأخذ هواه باتباعها كان غضبه وانتقامه بمقدار عدل، وأمن أن يعود عليه منه ضرر في نفسه أو في جسده في عاجل أمره وأجله.
في اطراح الكذب
هذا أيضا أحد العوارض الرديئة التي يدعو إليها الهوى. وذلك أن الإنسان لما كان يحب التكبر والترؤس من جميع الجهات وعلى كل الأحوال يحب أن يكون هو أبدا المخبر المعلم، لما في ذلك من الفضل له على المخبر المعلم. وقد قلنا إنه ينبغي للعاقل أن لا يطلق هواه فيما يخاف أن يجلب عليه من بعد هما وألما وندامة، ونجد الكذب يجلب على صاحبه ذلك، لأن المدمن للكذب المكثر منه لا يكاد تخطئه الفضيحة ولا يسلم منها، إما لمناقضة تكون منه لسهو ونسيان يحدثان له. وإما لعلم بعض من يحدثه واطلاعه من حديثه ذلك على خلاف ما ذكر. وليس يصيب الكذاب من الالتذاذ والاستمتاع بكذبه - ولو كذب عمره كله - ما يقرب فضلا عما يوازي ما يدفع إليه - ولو مرة واحدة في عمره كله - من هم الخجل والاستحياء عند افتضاحه واحتقار الناس واستصغارهم وتسفيههم وترذيلهم له وقلة ركونهم إليه وثقتهم به، إن كان ممن لنفسه عند نفسه مقدار ولم يكن في غاية الخسة والدناءة. فإن مثل هذا لا ينبغي أن يعد في الناس فضلا عن أن يكون يقصد بكلام يطمع به في صلاحه. ومن أجل أن أسباب الفضيحة في هذا المعنى ربما تأخرت كثيرا ما يغتر الجاعل بذلك، إلا أن العاقل ليس يورط نفسه فيما يخاف أو لا يأمن معه الفضيحة، بل يستظهر ويأخذ بالحزم في ذلك.
وأقول: إن الإخبار بما لا حقيقة له نوعان، فنوع منه يقصد به المخبر إلى أمر جميل مستحسن يكون له عند تكشف الخبر عذرا واضحا نافعا للمخبر، موجبا لأن يسوق ذلك الخبر إليه على ما ساقه إليه وإن لم يكن حقيقة كذلك. مثال ذلك أنه لو أن رجلا علم من ملك ما أنه مزمع على قتل صاحب له في يوم غدٍ، وأنه متى انقضى يومُ غدٍ ظهر الملك على أمرٍ ما يوجب أن يقتل صاحبه هذا، فجاء إلى صاحبه وأخبره أنه استخفى في منزله كنزاً وأنه يحتاج إلى معاونته عليه في يوم غدٍ، فأخذ به إلى منزله فلم يزل يومه ذلك يعلله بل يُكِدّه بالحفر والبحث عب ذلك الكنز، حتى إذا انقضى ذلك اليوم وظهر الملك على ما ظهر عليه أخبره حينئذٍ بالأمر على حقيقته. أقول إن هذا الرجل وإن كان قد أخبر صاحبه أولاً بما لا حقيقة له فليس في ذلك بمذموم ولا عند تكشُف الخبر على خلاف ما حكاه بمفتضح، إذ كان قد قصد به إلى أمرٍ جميل جليل نافعٍ للمُخبر. فهذا وما أشبهه ونحاه من الإخبار مما لا حقيقة له لا يُعقب صاحبه فضيحةً ولا مذمةً ولا ندامةً بل شُكراً وثناءً جميلاً. وأما النوع الثاني العديم لهذا الغرض ففي تكشُّفه الفضيحةُ والمذمة. وأما الفضيحة فإذا لم يكن على المُخبر من ذلك ضررٍ، كرجل حكى لصاحبه أنه عاين بمدينة كذا وكذا حيواناً أو جوهراً أو نباتاً من حالته وقصته كذا وكذا، مما لا حقيقة له ولا يقصد به الكاذبون إلا إلى التعجب منه فقط. وأما المذمة فإذا جلب على المخبر مع ذلك ضرراً، كرجل حكى لصاحبه عن ملك بلدةٍ ما شاسعة رغبةً في قُربه وتوقاناً إليه، وحقق في نفسه أنه إن احتمل إليه وسار نحوه نال منه مكان كذا ومرتبة كذا، وإنما فعل ذلك لينال شيئاً مما يخلفه، حتى إذا تعنى صاحبه وتحمل واجتهد فورد على ذلك الملك لم يجد لشيءٍ من ذلك حقيقةً، ووجده حَنِقاً مُغضَباً عليه فأتى على نفسه. على الأولى بأن يسمى كاذباً ويُجنب ويحترس منه مَن كذب لا لأمر اضطُرَّ إليه ولا مَطلبٍ عظيم ينال به، فإن مَن استحسن الكذب وأقدم عليه لأغراض دنتة خسيسة كان أحرى وأولى به عند الأغراض العظيمة الجليلة.
في البخل
إنّ هذا العارض ليس يمكننا أن نقول إنه من عوارض الهوى بإطلاق وذلك أنّا نجد قوماً يدعوهم إلى التمسك والتحفظ بما في أيديهم فرط خوفهم من الفقر وبُعد نظرهم في العواقب وشدةُ أخذٍ منهم بالحزم في الاستعداد للنكبات والنوائب، ونجد آخرين يلذون الإمساك لنفسه لا لشيء آخر، ونجد من الصبيان الذين لم يستحكم فيهم الروية والفكر من يسخو بما معه لقرنائه من الصبيان ونجد منهم من يبخل به. فمن أجل ذلك ينبغي أن يُقصد إلى ومقاومة ما كان من هذا العارض عن الهوى فقط، وهو الذي إذا سئل صاحبه عن السبب والعلة في إمساكه لم يجد في ذلك حجةً بينةً مقبولةً تُنبئ عن عُذر واضح. لكن يكون جوابه ملزقاً مرقعاً ملجلجاً مثبجاً. وقد سألت مرةً رجلاً من الممسكين عن السبب الداعي له إلى ذلك، فأجابني بأجوبة من نحو ما ذكرت. وجعلت أبِّين له فسادها وأنه ليس مما اعتل به شيءٌ يوجب مقدار ما كان عليه من الإمساك. وذلك أني لم أسُمه أن يجود من ماله بما يبين عليه فضلاً عما يُجحف به أو يحطه عن مرتبته في غناه، فكان آخرُ جوابه أن قال هكذا أُحِبُّ وكذا اشتهى. فأعلمته حينئذٍ أنه قد حاد عن حكم العقل إلى الهوى، إذ كان ما يعتل به ليس بقادح في الحالة العاجلة التي هو عليها ولا في الحزم والوثيقة والنظر في العاقبة. فهذا المقدار من هذا العارض هو الذي ينبغي أن يُصلح ولا يُقارَّ الهوى عليه، وهو البخل بما يؤثر في الحالة الحاضرة انحطاطاً ولا فيما يرام بلوغه فيمال بعد بالمال ضعفاً ولا عجزاً. فأما من كان له عُذرٌ بيّن واضح من أحد هذين البابين أو من كليهما فليس ما عرض له الإمساك عن الهوى بل عن العقل والروّية، ولا ينبغي أن يزال عنه بل يزيد ويثبت عليه. وليس كل ممسك يسوغ له أن يحتج بالباب الثاني من هذين البابين. وذلك أن مَن كان من الناس آيساً من أن يبلغ بإمساكه رتبةً أعلى وأجلَّ من التي هو فيها كمن كان في أواخر عُمره أو في أقصى المراتب التي يمكن أن يبلغها مثله فليس لاحتجاجه بالباب الثاني من هذين البابين وجهٌ بتّةً.
في دفع الفضل الضارّ من الفكر والهمّ
إن هذين العرضين وإن كانا عَرضين عقليين فإن فرطهما مع ما يجلب من الألم والأذى ليس هو - في إقعادنا عن مطالبنا وقطعنا دونها - بدون تقصيرهما عما ذكرنا قبل حيث ذكرنا إفراط فعل النفس الناطقة. ولذلك ينبغي أن يكون العقل يريح الجسد منهما وأن ينيله من اللهو والسرور واللذة بقدر ما يبلغ له ما يصلحه ويحفظ عليه صحته لئلا يخور وينهد وينهك ويقطع بنا دون قصدنا. ومن أجل اختلاف طبائع الناس وعاداتهم تختلف مقادير احتمال الفكر والهم فيهم، فبعض يحتمل الكثير منهما غير أن يضر ذلك به، وبعض لا يحتمل. فينبغي أن يتفقد ذلك ويتدارك قبل أن يعظم وأن يتدرج إلى الازدياد منه ما أمكن، فإن العادة تعين على ذلك وتقوى عليه. وبالجملة فإنه ينبغي أن يكون نيلنا وإصابتنا من اللهو والسرور واللذة لا أنها لها لنفسها، بل لكي نتجدد ونقوى به على العدو في فكرنا وهمنا اللذين بهما نبلغ مطالبنا. فإنه كما قصد الرجل السائر في إعلاف دابته ليس إلى أن ينيلها لذاتها بل إلى أن يقويها على بلوغ مكانه ومستقره، فكذلك ينبغي أن يكون حالنا في الاشتغال بمصالح أجسادنا. فإنه إذا فعلنا ذلك وقدرناه هذا التقدير بلغنا مطالبنا في أسرع الأوقات التي يمكن في مثلها بلوغها، ولم نكن كالذي أهلك راحلته قبل بلوغه أرضه التي يؤمها بالحمل عليها والخرق بها، ولا كالذي شغل بإسمانها وإخصابها حتى فاته الوقت الذي كان ينبغي أن يكون قد وصل فيه إلى موضعه ومستقره. وسنأتي في ذلك بمثل آخر، أقول: لو أن رجلا أحب علم الفلسفة وآثرها حتى جعلها همه وشغل بها فكره، ثم رام أن يبلغ منها ما بلغ سقراطيس وأرسطوطاليس وثوفرسطس وأوذيمس وخروسبس وثامسطيس واسكندروس في مدة سنة مثلا، فأدام الفكر والنظر وأقل الغذاء والراحة - ومما يتبع ذلك ضرورة دوام السهر -، أقول إن هذا الرجل يقع إلى الوسواس والملنخوليا وإلى الدق والذبول قبل مضي تمام هذه المدة وقبل أن يقارب هؤلاء الذين ذكرناهم. وأقول لو أن رجلا آخر أحب أيضا استكمال علم الفلسفة على أنه إنما ينظر فيها في الوقت بعد الوقت إذا فرغ من أشغاله ومل من لذاته وشهواته، فإذا عرض له أدنى شغل أو تحركت فيه أدنى شهوة ترك النظر وعاد فيما كان فيه أولا، أقول إن هذا الرجل لا يستكمل علم الفلسفة في عمره ولا يقارب ذلك ولا يدانيه. فقد عدم هذان الرجلان مطلوبهما أحدهما من جهة الإفراط والآخر من جهة التقصير. ومن أجل ذلك ينبغي أن نعتدل في فكرنا وهمومنا التي نروم بها بلوغ مطالبنا لنبلغها ولا نعدمها من قبل تقصير أو إفراط.
في دفع الغم
إن الهوى إذا تصور بالعقل فقد الموافق المحبوب عرض فيه الغم. ونحتاج في بيان أن الغم عرض عقلي أو هوائي إلى كلام فيه فضل طول ودقة. وقد ضمنا في أول هذا الكتاب أن لا نتعلق فيه من الكلام إلا بما لا بد منه في غرضه الذي أجريناه إليه، ومن قبل ذلك نتجاوز الكلام في هذا المعنى ونصير إلى ما هو المقصود المطلوب بكتابنا هذا. على أنه قد يمكن من كان به أدنى مسكة من علم الفلسفة أن يستنبط ويستخرج هذا المعنى من الرسم الذي رسمنا به الغم في أول هذا الكلام، إلا أنا نحن ندع ذلك ونتجاوزه إلى ما هو المطلوب بهذا الكتاب فأقول: إنه لما كان الغم يكدر الفكر والعقل ويؤذي النفس والجسد حق لنا أن نحتال لصرفه ودفعه أو التقليل منه والتضعيف له ما أمكن. وذلك يكون من وجهين، أحدهما بالاحتراس منه قبل حدوثه لئلا يحدث أو يكون ما يحدث أقل ما يمكن، والآخر دفع ما قد حدث ونفيه إما كله وإما أكثر ما يمكن منه والتقدم بالتحفظ لئلا يحدث أو ليقل أو يضعف ما يحدث منه، وذلك يكون بتأمل هذه المعاني التي أنا ذاكرها أقول: إنه لما كانت المادة التي منها تتولد المغموم إنما هي فقد المحبوبات، ولم يمكن أن لا تفقد هذه المحبوبات لتداول الناس لها وكرور الكون والفساد عليها، وجب أن يكون أكثر الناس وأشدهم غما من كانت محبوباته أكثر عددا وكان لها أشد حبا، وأقل الناس غما من كانت حاله بالضد من ذلك. فقد ينبغي إذا للعاقل أن يقطع مواد الغموم عمه بالاستقلال من الأشياء التي يجلب فقدها غما، ولا يغتر وينخدع بما نعها - ما دامت موجودة - من الحلاوة، بل يتذكر ويتصور المرارة المجرعة عند فقدها فإن قال قائل إن من توقّى اتخاذ المحبوبات واقتناءها خوفا من الغم عند فقدها فقد استعجل غماً، قيل له إنه وإن كان هذا المتوقَّى المحترس قد استعجل غما فليس ما استعجله بمساوٍ لما خاف الوقوع فيه منه. وذلك أنه ليس اغتنام مَن ولد له كاغتنام من أُصيب بولده هذا إن كان الرجل ممن يغتنم بأن لا يكون له ولدٌ فضلاً عن غيره ممن لا يبالي ولا يعبأ بذلك ولا يغتمُّ له بتّةً ولا غمُّ من لا معشوق له كغم مَن فقد معشوقه. وقد حُكي عن بعض الفلاسفة أنه قيل له لو اتخذت ولداً. فقال إني من السعي في إصلاح جسدي هذا ونفسي هذه في مؤنٍ وغمومٍ لا قِوامَ لي بها، فكيف أضُم وأقرن إليها مثلها؟ وسمعت مرأةً عاقلةً تقول إنها عاينت يوماً مرأةً شديدة التحرق على ولدٍ لها أصيبت به وأنها توقت الدنو من زوجها خوفا من أن ترزق ولدا تبلى فيه بمثل بلائها. ومن أجل أن وجود المحبوب موافق ملائم للطبيعة وفقده مخالف منافر لها صارت تحس من ألم فقد المحبوب ما لا تحس من لذة وجوده. ولذلك صار الإنسان يكون صحيحا مدة طويلة فلا يحس لصحته بلذة، فإن اعتل بعض أعضائه أحس على المكان فيه بألم شديد. وكذلك تصير المحبوبات كلها عند الإنسان - إذا وجدها أو طالت صحبتها له - في سقوط لذة وجودها عنه ما دامت موجودة له وحصول شدة ألم فقدها عليه إذا فقدها ومن أجل هذا لو أن رجلا استمتع دهرا طويلا بأهل وولد ثم بلى بفقدهما لأحس من التألم في يوم واحد وساعة واحدة ما يفضل ويأتي على لذة إمتاعه كان بهما. وذلك أن الطبيعة تحسب وتعد ذلك الاستمتاع الطويل كله حقا واجبا لها، بل تعده دون حقها. وذلك أنها لا تخلو في تلك الخالة أيضا من استقلال ما هي فيه الزيادة منه دائما بلا نهاية حبا منها للذة واشتياقا إليها. وإذا كان الأمر على هذا - أعني أن يكون التلذذ والاستمتاع بالمحبوبات في حال وجودها معوزا منطمسا مستقلا مغفلا، والحزن والتحرق والتلظي عند فقدها متبينا مستكثرا مؤلما متلفا - فما الرأي إلا طرحها بتت أو الاستقلال منها لتعدم أو تقل عواقبها الرديئة الجالبة للغموم المؤذية المضنية. فهذه أعلى المراتب في هذا الباب وأحمسها لمواد الغموم. ويتلوه في ذلك أن يتمثل الرجل ويتصور فقد محبوباته ويقيمها في نفسه ووهمه ويعلم أنها ليس مما يمكن أن تبقى وتدوم بحالها، ولا يخلو من تذكر ذلك منها وإخطار ذلك بباله فيها وتصحيح العزم وشدة الجلد متى حدث ذلك بها. فإن ذلك تمرين وتدريج ورياضة وتقوية للنفس على قلة الجزع عند حدوث المصائب لقلة ما كان من اعتياده وثقته وركونه إلى بقاء محبوباته في حال وجودها ولكثرة ما مثل للنفس وعودها وآنسها بتصور المصائب قبل حدوثها. وفي مثل هذا المعنى يقول الشاعر:
يصوِّر ذو الحزم في نفسه ... مصائبَه قبل أن تنزلا
فإن نزلت بغتةً لم تُرِعْهُ ... لِما كان في نفسه مَثَّلا
رَأَى الأمر يُفضي إلى آخِرٍ ... فصيرِّ آخِرَه أوّلا
فإن كان هذا الإنسان في غاية الفشالة ومفرط الميل مع الهوى واللذة ولا يثق من نفسه باستعمال شئ من هذين البابين فليس إلا أن يحتال أن ينفرد من محبوباته بواحدة ينزلها منزلة ما لا بد منه وما ليس غيره، بل يقرن إليها ويتخذ منها ما ينوب - أو يقارب أن ينوب - عن مفقود إن فقد منها، فإنه بهذا الوجه يمكن أن لا يفرط حزنه واغتمامه بأي واحد فقد منها. فهذه جملة يحترس به من كون الغم ووقوعه. فأما ما يدفع به أو يقلل منه إذا كان ووقع فإنا قائلون فيه منذ الآن. فنقول: إن العاقل إذا تفقَّد ونظر فيما يعتوره الكونُ والفسادُ من هذا العالم ورأى أن عنصرها عنصرٌ مستحيل منحلّ سيّال لا ثباتَ لشيءٍ منه ولا دَوامَ له بالشخصية، بل كلها زائل داثر مستحيل فاسد مضمحل، فلا ينبغي أن يَستكثر ويَستظعم ويستفظع ما سُلب منه وفُجع به منها، بل يجب عليه أن يَعُدَّ مُدَّةَ بقائها له فضلاً، وما استمتع به من ذلك رِبحاً، إذ كان فناؤها وزوالها كائناً لا محالة، ولا يَعظم ويَكبر ذلك عليه وقتَ كونه إذ كان شيئاً لا بد أن يَعرض فيها. فإنه متى أحبَّ دوام بقائها فقد رام ما لا يمكن وجودهُ لها، ومن أحب ما لا يمكن وجوده كان جالباً بذلك الغمَّ إلى نفسه ومائلاً عن عقله إلى هواه وأيضاً فإن فقد الأشياء التي ليست بأضطرازية في بقاء الحياة ليس يدوم له الغمُّ بها والحزنُ عليها، لكن يسرع منها البديل وعنها النائب ويُعقب ذلك السلوةَ عنها والنسيان لها، فترجع العيشةُ وتعود الحالةُ إلى ما كانت عليه قبل المُصيبة فكم رأينا ممن أُصيب بعظيم المصائب وفادحها راجعاً إلى ما لم يزل عليه قبل مُصابه ملتذاً بعيشه مغتبطاً بحاله. فلذلك ينبغي للعاقل أن يذكِّر النفس في حال المُصيبة بما تَؤُول وترجع إليه من هذه الحالة ويعرضه عليها ويشوِّقها إليه ويجتلب ما يَشغل ويُلهي أكثر ما يمكن لُسرع الخروج منها إلى هذه الحالة وأيضاً فإن تذكُّرَه كثرةَ المشاركين له في المصائب وأنه لا يكاد يَعْرَى منها أحدٌ وتذكُّرَ حالاتهم بعدُ وأبواب سلوتهم وحالاته وسلوا ته نفسه عن مصائب إن كانت تقدَّمت له مما يخفِّف ويسكن من عادية الغم. وأيضاً فإنه إن كان أكثرُ الناس وأشدُّهم غمّاً من كانت محبوباته أكثر عدداً وكان لها أشدَّ حُباً فإنه ليس من واحدٍ يفقد منها إلا وفقد من الغم على مقداره، بل يُريح نفسه من همٍ دائم وخوفٍ عليه منتظر، ويحدث له وجرة وجَلَد على ما يحدث منها بعدُ، فقد جرَّ فقدُها نفعاً وإن كان الهوى لذلك كارهاً، فاكتسب راحةً وإن كان متذوقها مراً وفي مثل هذه المعاني يقول الشاعر:
لَعمرِي لَئِن كنّا فَقَدناكَ سيِّداً ... وكهفاً له طالَ التَحزُّنُ والهَلَع
لقد جَرَّ نفعاً فَقْدُنا لك أنّنا ... أَمِنّا على كلِّ الرَزايا من الجَزَع
فأما ما يعتصم به المؤثر لاتباع ما يدعوه إليه عقله وتجنُّب ما يدعوه إليه هواه، التامُّ الملكةِ والضابطُ لنفسه من الغم فواحدة، وهي أن العاقل الكامل لا يختار المُقام على حالةٍ تضرُّه، ومن أجل ذلك يبادر إلى النظر في سبب الغم الوارد عليه. فإن كان مما يمكن دفعه وإزالتهُ جعل بدل الاغتنام فكراً في الحيلة لدفع ذلك السبب وإزالته، وإن كان ذلك فيه أخذ على المكان في التلهي عنه والتناسي له وعَمِلَ في محوه عن فكره وإخراجه عن نفسه. وذلك أن الذي يدعوه إلى المُقام على الاغتنام في هذه الحالة الهوى لا العقل، إذ العقل لا يدعو إلا إلى ما جلب نفعاً عاجلاً وآجلاً، وكان الاغتنام مما لا دَرَكَ فيه بتةً ولا عائدةَ منه بل فيه ضررٌ عاجل يؤدِّي إلى ضرر آجل فضلاً عن أن يكون نافعاً. وهو أعني الرجل العاقل الكامل لا يتبع إلا ما دعاه إليه العقل ولا يُقيم إلا على ما أُطلق له المقامُ عليه لسببٍ وعذرٍ واضح، ولا يتبع الهوى ولا ينقاد له ولا يقاربه على خلاف ذلك.
في الشَرَه
إن الشَرَه والنهم من العوارض الرديئة العائدة من بَعدُ بالألم والمضرّة وذلك أنه ليس إنما يجلب على الإنسان استنقاص الناس له واسترذالهم إياه فقط، ولكن يطرحه مع ذلك في سوء الهضم، ومن سوء الهضم إلى ضروب من الأمراض الرديئة جداً. ويتولد عن قوة النفس الشهوانية، وإذا انضمّ إليها وساعدها عمى النفس الناطقة الذي هو قلة الحياء كان مع ذلك ظاهراً مكشوفاً. وهو أيضاً ضربٌ من أتباع الهوى يدعو إليه ويحمل عليه تصورُّ استلذاذ طعم المتطِّم. ولقد بلغني أن رجلاً من أهل الشره أقبل يوماً على ضروب من الطعام بنهم وشره شديد، حتى إذا تضلع وتملأ منها لم يمكنه معه تناول شيء بتّةً، فأخذ يبكي فسؤلَ عن سبب بكائه، فقال إن ذلك لأنه زعم لا يقدر على أكل شيء مما هو بين يديه. وقد كان رجل بمدينة السلام يأكل معي من رَطبٍ كثير كان بين أيدينا، فأمسكت بعد تناولي منه مقداراً معتدلاً، وأمعن هو حتى قارب أن يأتي على جميعه. فسألته بعد امتلائه منه وإمساكه عنه وذلك أنَّي رأيته محدقاً نحو ما رُفع من بين أيدينا منه هل انتهت نفسه وسكنت شهوتهُ؟ فقال ما كنت أُحب إلا أن أكون بحالتي الأولى ويكون هذا الطبق إنما قُدِمَ إلينا الآن. فقلت له فإذا كان ألمُ حِسِّ الاشتهاء ومضضه لم يسقط عنك ولا في هذه الحال فما كان الصواب إلا الإمساك قبل التملي لتُريح النفس مما أنت فيه الآن من الثِقَل والتمدُّد بالتملي، وما لا تأمن أن تصير إليه من سوء الهضم الذي يجلب عليك من الأمراض ما يكون تألُمك به أكثر من التذاذك بما تناولته أضعافاً كثيرةً. فرأيته قد فهم معنى هذا الكلام وبَجَّع فيه وبلغ إليه. ولعمري إن هذا الكلام ونحوه يُقنِع مَن لم يكن مرتاضاً برياضات الفلسفة أكثر مما تُقنع الحجج المبينةُ على الأصول الفلسفية. وذلك أن المعتقد أن النفس الشهوانية إنما قُرنت إلى الناطقة لتنال هذا الجسد الذي هو للنفس الناطقة بمنزلة أداة أو آلة ما يبقى به مدّة اكتساب النفس الناطقة المعرفة بهذا العالم، يقمع النفس الشهوانية ويمنعها من الإصابة من الغذاء فوق الكفاف، إذ كان يرى أن الغرض والقصد بالأغتذاء في الخلقة ليس للأتذاذ بل للبقاء الذي لا يمكن أن يكون إلا به. وذلك كما حُكي عن بعض الفلاسفة أنه كان يأكل مع بعض الأحداث ممن لا رياضة له، فاستقلّ ذلك الحدث أكلَ الفيلسوف ويتعجب منه وقال له في بعض كلامه لو كان زَرَدي من الغذاء مثل زَرَدك لم أُبالِ أن لا أعيش. فقال له الفيلسوف أجل يا بني، أنا آكل لأبقى وأنت تُريد أن تبقى لتأكل. وأما من لا يرى أن عليه من التملي والاستكثار من الغذاء بأساً في مذهبه ورأيه فإنما ينبغي أن يُدفَع عن ذلك بالكلام في الموازنة للذّة المُصابة من ذلك بالألم المُعقِبِ لها كما ذكرنا قُبيل. ونقول أيضاً: إنه إذا كان انقطاع الطعم المستلذ عن المتطعم مما لا بد منه فقد ينبغي للعاقل أن يقدِّم ذلك قبل الحال التي لا يأمن معها عاقبةً رديئةً. وذلك أنه إن لم يفعل ذلك خَسِرَ ولم يربح. أما خُسرانه فتعريض النفس للألم والسقم، وأما أنه لم يربح فلأن مَضَض انقطاع لذة المتطعم عنه قائمٌ على حال، فمتى انحرف عن هذا أو مال إلى ضدّه فليعلم أنه قد ترك عقله لهواه. وأيضاً فإن للشَرَه والنهم ضراوةً واستكلاباً شديداً، ومتى أُهمل وأُمرج قَوِيَ ذلك منه وعَسُرَ نزوع النفس عنه. ومتى رُدع وقُمع وَهَن ودَبُل وضعف على الأيام حتى يُفقد البتّة. فقال الشاعر:
وعادة الجُوع فأعلم عِصمَةٌ وغنىً ... وقد تَزيدُك جوعاً عادةُ الشِبَع
في السُكر
إن إدمان السُكر ومواترته أحد العوارض الرديئة المؤدية بصاحبها إلى المهالك والبلايا والأسقام الجمّة. وذلك أن المُفرط في السُكر مُشرفٌ في وقته على السكتة والاختناق وعلى امتلاء بطن القلب الجالب للموت فجأةً وعلى انفجار الشرايين التي في الدماغ وعلى التردِّي والسقوط في الأغوار والآبار، ومِن بعدُ فعلى الحُميَّات الحارة والأورام الدموية والصفراوية في الأحشاء والأعضاء الرئيسية وعلى الرعشة والفالج لا سيما إن كان ضعيف العصب. هذا إلى سائر ملا يجلب على صاحبه من فقد العقل وهتك الستر وإظهار السر والقعود به عن إدراك جل المطالب الدينية الدنيائية، حتى إنه لا يكاد يتعلق منها بمأمولٍ ولا يبلغ منها حُظوةَ، بل لا يزال منها منحطّاً متسفِّلاً. وفي مثاله يقول الشاعر:
متى تَدرِكُ الخيراتِ أو تستطيعُها ... ولو كانت الخيراتُ منك على شِبرِ
إذا بِتَّ سَكراناً وأصبحتَ مُثقَّلاً ... خماراً وعاودتَّ الشرابَ مع الظُهرِ
وبالجملة فإن الشراب من أعظم موادِّ الهوى وأعظم آفات العقل، وذلك أنه يقوِّي النفسين - أعني الشهوانية والغضبية - ويشحذ قواهما حتى يطالباه بالمبادرة إلى ما يُحبانه مطالبةً قويةً حثيثةً، ويوهن النفس الناطقة ويبلد قواها حتى لا تكاد تستقصي الفكر والروية بل تُسرِع العزيمةَ وتُطلق الأفعال قبل إحكام الصريمة، ويسهل ويسلس انقيادها للنفس الشهوانية حتى لا تكاد تُمانعها ولا تتأبى عليها، وهذه مفارقة النطق والدخول في البهيمية. ومن أجل ذلك ينبغي للعاقل أن يتوقاه ويحله هذا المحل وينزله هذه المنزلة ويحذره حذر مَن يروم سَلبَ أفضل عقده وأنفسها. فإن نال منه شيئاً ما ففي حال كَظَّ الفكر والهم له وغموظهما إياه، وعلى أن لا يكون قصدُه وغرضه فيه إيثار اللذة واتباعها في مطلوباتها، بل دفع الفضل منهما والسرف فيهما الذي لا يؤمن معه سوء الحال وفساد المزاج. وينبغي أن يتذكر في هذا الموضع وأمثاله ما بيّنّاه في باب قمع الهوى، ويتصور تلك الجُمَلَ والجوامع والأصول لئلا يحتاج إلى إعادة ذكرها وتكريرها، ولا سيما قولنا إن الإدمان والمثابرة على اللذات يُسقط الالتذاذ بها ويجعلها بمنزلة الشيء الاضطراري في بقاء الحياة، فإن هذا المعنى يكاد أن يكون في لذة السُكر أوكد منه في سائر اللذات. وذلك أن السِكِّير يصير بحالةٍ لا يرى العيش إلا مع السكر، وتكون حالةَ صَحوة عنده كحالة مَن قد لزمته همومٌ اضطرارية. وأيضاً فإن ضراوة السُكر ليست بدون ضراوة الشره بل أكثر منه كثيراً، وبحسب ذلك ينبغي أن تكون سرعةُ تلاحُقه وشدة الزم والمنع منه. وقد يُحتاج إلى الشراب ضرورةً في دفع الهم وفي المواضع التي يًحتاج فيها إلى فضلٍ من الانبساط ومن الجُرأة والإقدام والتهور، وينبغي أن يُحذر ولا يقرب البتّة في المواضع التي يُحتاج فيها إلى فضل فكر وتبين وتثبت.
في الجماع
إن هذا أيضاً أحد العوارض الرديئة التي يدعو إليها ويحمل عليها الهوى وإيثار اللذة الجالبةِ على صاحبها ضروب البلايا والأسقام الرديئة. وذلك أنه يضعف البصر ويهد البدن ويُخلِقه ويَسرع بالشيخوخة والهرم والذبول ويُضر بالدماغ والعصب ويسقط القوة ويوهنها، إلى أمراض أُخر كثيرة يطول ذكرها وله ضراوةٌ شديدة كضراوة سائر الملاذ بل أقوى وأشد منها بحسب ما تذكر النفس من فضل لذته عليها. ومع ذلك فإن الإكثار من الباه يوسِّع أوعية المنِّي ويجلب إليها دماً كثيراً يكثر من أجل ذلك تولَّد المني فيها، فتزداد الشهوة له والشوق إليه وتتضاعف. وبالضد من ذلك فإن الإقلال منه والإمساك عنه يحفظ على الجسد الرطوبة الأصلية الخاصيّة بجوهر الأعضاء، فتطول مدة النشوء والنماء وتُبطئ الشيخوخة والجفاف والقحل والهرم وتضيق أوعيةُ المني ولا تستجلب المواد، فيقل تولد المني فيها ويضعف الانتشار ويتقلص الذَكَر وتسقط الشهوة وتعدم شدةُ حثها ومطالبتها به ولذلك ينبغي للعاقل أن يزم نفسه عنه ويمنعها منه ويجاهدها على ذلك لئلا تغرى به وتضرى عليه، فتصير إلى حالةٍ تعسر ولا يمكن صدها عنه ومنعها منه. ويتذكر ويُخطر بباله جميع ما ذكرناه من زمَّ الهوى ومنعه، ولا سيما ما ذكرناه في باب الشره من ثبوت مضض الشهوة ورمضها وحثها ومطالبتها مع النيل من المشتهي والبلوغ منه غاية ما في الوسع. وذلك أن هذا المعنى في اللذة المصابة بالجماع أوكد وأظهر منه في سائر اللذات لِما يتصور من فضل لذته على سائرها فالنفس - لاسيما المهملة الممرجة الغير مؤدبة التي يسميها الفلسفة الغير مقموعة - لا يُسقط عنها الإدمان للباه شهوتها ولا الاستكثار من السر أري الشوق والنزوع إلى غيرهن. ولأن ذلك ليس يمكن أن يتم بلا نهاية فلا بد أن يصلى بحر فقد الالتذاذ بالمشتهى ورمضائه، ويقاسي ويكابد ألم عَدَمه مع ثبوت الداعي إليه والباعث عليه، إما لِعَوَزٍ من المال والممكنة وإما لضعفٍ وعجزٍ في الطبع والبنية، إذ كان ليس يمكن فيها أن ينال من المشتهي المقدار الذي تُطالب به الشهوة وتدعو إليه، كحالة الرجلين المذكورين في باب الشَرَه. وإذا كان الأمر على هذا فليس الصواب إلا تقديم هذا الأمر الذي لا بد منه ومن وقوعه ومقاساته - أعني فقد الالتذاذ بالمشتهي مع قيام الباعث عليه الداعي إليه - قبل الإفراط فيه والاستكثار منه، ليأمن عواقبه الرديئة ويزيح ضراوته واستكلابه وشدة حثه ومطالبته. وأيضاً فإن هذه اللذة من أولى اللذات وأحقها بالاطراح. وذلك أنها ليست اضطرارية في بقاء العيش كالطعام والشراب، وليس في تركها ألم ظاهر محسوس كألم الجوع والعطش، وفي الإفراط فيها والإكثار منها هدم البدن وهده. فليس الانقياد للداعي إليها والمرور معه سوى غلبة الهوى وطموسه العقل الذي يحق على العاقل أن يأنف منه ويرفع نفسه عنه ول يُشبه فيه الفحولة من التيوس ومن الثيران وسائر البهائم التي ليس معها رَوية ولا نظر في عاقبة. وأيضاً فإن استقباح جلِّ الناس وجمهورهم لهذا الشيء واستسماجهم له وإخفاءهم إياه وسترهم لما يؤتى منه يوجب أن يكون أمراً مكروهاً عند النفس الناطقة. وذلك أن اجتماع الناس على استسماجه لا يخلو أن يكون إما بنفس الغريزة والبديهة وإما بالتعليم والتأديب، وعلى أي الوجهين كان فقد وجب أن يكون سَمِجاً رديئاً في نفسه. وذلك قد قيل في القوانين البرهانية إن الآراء التي ينبغي أن يُشَكّ في صحتها هي ما اجتمع عليه كل الناس أو أكثرهم أو أحكمهم. وليس ينبغي لنا أن ننهمك في إتيان الشيء السمج القبيح بل الواجب علينا أن ندعه البتة، فإن كان لا بد منه فيكون الذي نأتي منه أقلَّ ما يمكن مع الاستيحاء واللوم لأنفسنا عليه، وإلا كنا مائلين عن العقل إلى الهوى وتاركيه له. وصاحب هذه الحال أخسَّ عند العقلاء وأطوع للهوى من البهائم لإيثاره ما دعا إليه الهوى وانقياده له في ذلك مع إشراف العقل به على ما في ذلك عليه وزجره له، والبهيمة إنما تنقاد لِما في الطباع من غير زاجرٍ ولا مُشرفٍ بها على ما عليها فيه.
في الوَلَع والعَبَث والمذهب
ليس يُحتاج في ترك هذين - أعني العبث والولع - والإضراب عنهما إلا إلى صحة العزم على تركمهما والاستيحاء والأنف منهما، ثم أخذ النفس بتذكر ذلك في أوقات العبث والولع، حتى يكون ذلك العبث والولع نفسه عنجه بمنزلة الرتيمة المذكرة. وقد حُكى عن بعض العقلاء من الملوك أنه كان يوَلَعُ ويعبث بشيء من جسده - أحسبه لحيته - فطال ذلك منه وكثر قول مَن يقرب إليه له فيه، فكأن السهو والغفلة يأبيان إلا ردَّة إليه. حتى قال بعض وزرائه ذات يوم يا أيها الملك جرِّد لهذا الأمر عزمةً من عزمات أولي العقل. فأحمر الملك واستشاط غضبا، ثم لم ير عائدا إلى شئ من ذلك البتة. فهذا الرجل أثارت نفسه الناطقة نفسه الغضبية بالحمية والأنف وصح العزم وتأكد في النفس الناطقة حتى أثر فيها أثرا قويا صار مذكرا به ومنبها له عليه متى غفل عنه. ولعمري إن النفس الغضبية إنما جعلت لتستعين بها الناطقة على الشهوانية متى كانت شديدة النزاع قوية المجاذبة عسرة الانقياد. وإنه يحق على العاقل أن يغضب ويدخله الأنف والحمية متى رأى الشهوة تروم قهره وغلبته على رأيه وعقله، حتى يذلها ويقمعها ويقفها على الكرة والصغار عند حكم العقل ويجبرها عليه. وإنه من العجب - بل مما لا يمكن بتّةً - أن يكون من يقدر على وم نفسه عن الشهوات مع ما لها من الدواعي والبواعث القوية يعسر عليه منعها من الولع والعبث وليس فيهما كبير شهوة ولا لذة. وأكثر ما يحتاج إليه في هذا الأمر التذكر والتيقظ لأنه إنما يكون في أكثر الأحوال مع السهو والغفلة فأما المذهب فإنه مما يحتاج فيه إلى كلام يبين به أنه عرض هوائي لا عقلي، وسنقول في ذلك قولا وجيزا مختصرا. أقول: إن النظافة والطهارة إنما ينبغي أن تعتبر بالحواس لا بالقياس ويجري الأمر فيهما بحسب ما يبلغه الإحساس لا بحسب ما يبلغه الوهم. فما فات الحواس أن تدرك منه نجاسة سميناه طاهرا، وما فاتها أن تدرك منه قذرا سميناه نظيفا. ومن أجل أنا نقصد هذين ونريدهما - أعني الطهارة والنظافة - إما للدين وإما للتقذر، وليس يضرنا ولا في واحد من هذين المعنيين ما فاته الحواس قلة من الشيء النجس والشيء القذر - وذلك أن الدين قد أطلق الصلاة في الثوب الواحد الذي قد ماسته أرجل الذبان الواقعة على الدم والعذرة. والتطهر بالماء الجاري ولو علمنا أنه مما يبال فيه، وبالراكد في البركة العظيمة ولو علمنا أن فيه قطرة من دم أو خمر - وليس يضرنا ذلك في التقذر - وذلك أن ما فات حواسنا لم نشعر به، وما لم نشعر به لم يخش أنفسنا منه، وما لم تخش أنفسنا منه فليس لتقذرنا معنى البتة - فليس يضرنا إذا الشيء النجس والقذر إذا كان مستغرقا فائتا لقلته، ولا ينبغي أن نفكر فيه ولا يخطر وجوده لنا على بال. وإن نحن ذهبنا نطلب الطهارة والنظافة على التحقيق والتدقيق وجعلناه وهميا لا حسيا لم نجد سبيلا أبدا إلى شئ طاهر ولا شئ نظيف على هذا الحكم. وذلك أن الأمواه التي نستعملها ليس بمأمون عليها تقذير الناس لها أو وقوع جيف السباع والهوام والوحش وسائر الحيوان وأزبالها وأذواقها فيها. فإن نحن استكثرنا من إفاضته وصبه علينا لم نأمن أن يكون الجزء الأخير هو الأقذر والأنجس. ولذلك ما وضع الله على العباد التطهر على هذه السبيل إذ كان ذلك مما ليس في وسعهم وقدرتهم. وهذا مما يبغض على المتقذر بالوهم عيشه إذ كان لا يصيب شيئا - يغتذي به وينقلب إليه - يأمن أن يكون فيه قذر مستغرق. وإن كانت هذه الأمور كما وصفنا لم يبق لصحب المذهب شئ يحتج به. وما أقبح بالعاقل أن يقيم على ما لا عذر له فيه ولا حجة له فيه ولا حجة له عنده لأن ذلك مفارقة للعقل ومتابعة الهوى الخالص المحض.
في الاكتساب والاقتناء والإنفاق
إن العقل الذي خصصنا به وفضلنا على سائر الحيوان غير الناطق به أدى بنا إلى حسن المعاش وارتفاق بعضنا ببعض. فإنا قل ما نرى البهائم يرتفق يعضها ببعض ونرى أكثر حسن عيشنا من التعاون والإرتفاق لبعضنا من بعض، فلولا ذلك لم يكن لنا فضل في حسن العيش على البهائم. وذلك أن البهائم لما لم يكن لها كمال التعاون والتعاضد العقلي على ما يصلح عيشنا لم يعد سعى الكثير على الواحد منها كما نرى ذلك في الإنسان. فإن الرجل الواحد منا طاعم كاس مستكن آمن، وإنما يزاول من هذه الأمور واحدا فقط لأنه إن كان حراثا لم يمكنه أن يكون بناء، وإن كان بناء لم يمكنه أن يكون حواكا، وإن كان حواكا لم يمكنه أن يكون محاربا. وبالجملة إنك لو توهمت إنسانا واحدا مفردا في فلاة لعلك لم تكن تتوهمه عائشا، ولو توهمته عائشا لم تكن تتوهم عيشه عيشا حسنا هنيئا، كعيش من قد وفر عليه كل حوائجه وكفى ما يحتاج أن يسعى فيه. بل عيشا وحشيا بهيميا سمجا، لما فقد من التعاون والتعاضد المؤدي إلى حسن العيش وطيبه وراحته. وذلك أنه لما اجتمع ناس كثير متعاونون متعاضدون اقتسموا وجوه المساعي العائدة على جميعهم، فسعى كل واحد منهم في واحد منها حتى حصلها وأكملها، فصار لذلك كل واحد منهم خادما ومخدوما وساعيا لغيره ومسعيا له. فطاب للكل بذلك المعيشة وتم على الكل بذلك النعمة وإن كان في ذلك بينهم بون بعيد وتفاضل كثير، غير أنه ليس من أحد إلا مخدوم مسعى له مكفى كل حوائجه وإذ قد قدمنا ما رأينا تقديمه في هذا الباب واجبا فإنا راجعون إلى غرضنا المقصود هاهنا. فنقول: إنه لما كانت عيشة الناس إنما تتم وتصلح بالتعاون والتعاضد كان واجبا على كل واحد منهم أن يتعلق بباب من أبواب هذه المعاونة ويسعى في الذي أمكنه وقدر عليه منها ويتوقى في ذلك طرفى الإفراط والتقصير. فإن مع أحدهما - وهو التقصير - الذلة والخساسة والدناءة والمهانة إذ كان يؤدي بالإنسان إلى أن يصير عيالا وكلا على غيره ومع الآخر الكد الذي لا راحة معه والعبودية التي لا انقضاء لها. وذلك أن الرجل متى رام من صاحبه أن ينيله شيئا مما في يديه من غير بدل ولا تعويض فقد أهان نفسه وأحلها محل من أقعدته الزمانة والنقص عن الاكتساب. وأما من لم يجعل للاكتساب حدا يقف عنده ويقتصر عليه فإن خدمته للناس تفضل على خدمتهم له أضعافا كثيرة، ولا يزال من ذلك في رق وعبودية دائمة. وذلك أن من سعى وتعب عمره كله باكتساب ما يفضل من المال عن نفقته ومقدار حاجته وجمعه وكنزه فقد خسر وخدع واستعبد من حيث لا يعلم. وذلك أن الناس جعلوا المال علامة وطابعا يعلم به بعضهم من بعض ما استحق كل واحد منهم بسعيه وكده العائد على الجميع. فإذا اختص أحدهم بجمع الطوابع بكده وجهده ولم يصرفها في الوجوه التي تعود بالراحة عليه من سعى الناس له وكفايتهم إياه كان قد خسر وخدع واستعبد. وذلك أنه أعطى كدا وجهدا ولم يستعض منه كفاية وراحة، ولا استبدل كدا بكد وخدمة بخدمة بل استبدل ما لم يجد ولم ينفع، فحصل جهده وكده وكفايته للناس فاستمتعوا به وفاته من كفاية الناس له وكدهم عليه واستمتاعه بهم دون قدر استحقاقه بكفايته لهم وكده عليهم، فقد خسر وخدع واستعبد كما ذكرنا. فالقصد في الاكتساب إذا هو المقدار الموازي لمقدار الإنفاق وزيادة فضلة تقتنى وتدخر للنوائب والحوادث المانعة من الاكتساب. فإنه يكون حينئذ المكتسب قد اعتاض كدا بكد وخدمة بخدمة.
وأما الاقتناء فإنا قائلون فيه منذ الآن فنقول: إن الاقتناء والادخار هو أيضا أحد الأسباب الاضطرارية في حسن العيش الكائن عن تقدمة المعرفة العقلية، والأمر في ذلك أظهر وأوضح من أن يحتاج إلى بيانه، حتى إن كثيرا من الحيوان غير الناطق يقتني ويدخر. وأخلق أن يكون لهذه الحيوانات فضل في التصور الفكري على غير المقتنية. وذلك أن سبب الاقتناء والباعث عليه تصور الحالة التي يفقد فيها المقتني مع قيام الحاجة إليه. فقد ينبغي أن يعتدل فيه على ما ذكرناه عند كلامنا في كمية الاكتساب. لأن التقصير فيه يؤدي إلى عدمه مع الحاجة إليه كالحالة فيمن ينقطع به الزاد في فلاة من الأرض، والإفراط يؤدي إلى ما ذكرنا أنه يؤدى إليه من دوام الكد والتعب، والاعتدال في الاقتناء هو أن يكون الإنسان مستظهرا من المقتنيات بمقدار ما يقيم به حالته التي لم يزل عليها متى حدثت عليه حادثة مانعة من الاكتساب. فأما من كان غرضه في الاقتناء التنقل به عن الحالة التي هو عليها إلى ما هو أعلى وأجل منها ولم يجعل لذلك حدا يقتصر عليه ويقف عنده فإنه لا يزال في كد ورق دائم، ويعدم أيضا مع ذلك في أية حال - من أية حال تنقل إليها - الاستمتاع والغبطة بها إذ لا يزال مكدودا فيها غير راض بها عاملا في التنقل منها إلى غيرها، متطلعا متشوقا إلى التعلق بما هو أجل وأعلى منها، على ما ذكرناه في باب الحسد ونذكره الآن بتفسير وشرح أوضح وأكثر في الفصل الذي يتلو هذا. وخير المقتنيات وأبقاها وأحمدها وآمنها عاقبة الصناعات لا سيما الطبيعية الاضطرارية التي الحاجة إليها دائمة قائمة في جميع البلدان وعند جميع الأمم. فإن الأملاك والأعلاق والذخائر غير مأمون عليها حوادث الدهر. ولذلك لم تعد الفلاسفة أحدا غنيا إلا بالصناعات دون الأملاك. وقد حكى عن بعضهم أنه كسر به في البحر فهلك جميع ماله، وأنه لما أفضى إلى الشط أبصر في الأرض رسم شكل هندسي، فطابت نفسه وعلم أنه قد وقع إلى جزيرة فيها قوم علماء. ثم إنه رزق فيهم الثروة والرياسة فأقام عندهم. فمرت به مراكب تريد بلده فسألوه هل عنده رسالة يحملونها عنه إلى أهل بلده. فقال لهم إذا صرتم إليهم فقولوا لهم اقتنوا وادخروا ما لا يغرق وأما كمية الإنفاق فإنا قد ذكرنا قبيل أن مقدار الاكتساب ينبغي أن يكون موازيا لمقدار الإنفاق والفضلة المقتناة المدخرة للنوائب والحوادث، فمقدار الإنفاق ينبغي إذا أن يكون أقل من مقدار الاكتساب. غير أنه لا ينبغي للمرء أن يحمله الميل إلى الاقتناء على التقتير والتضيُّق، ولا حب الشهوات وإيثارها على ترك الاقتناء البتة، بل يعتدل فيها كل واحد بمقدار كسبه وعادته التي جرت في الإنفاق ونشأ عليها وحاله ورتبته وما يجب أن يكون لمثله من القنية والذخيرة.
في طلب الرُتَب والمنازل الدنيائيّة
قد قدمنا في أبواب من هذا الكتاب جمل ما يُحتاج إليه في هذا الباب، غير أنا من أجل شرف الغرض المقصود بهذا الباب وعِظَم نفعه مُفرِدوه بكلام يخصه وناظمون ما تقدم من النكت والمعاني فيه، وضامّون إليه ما نرى أنه يعين على بلوغه واستتمامه فنقول: إن من يريد تزيين نفسه وتشريفها بهذه الفضيلة وإطلاقها وإراحتها من الأسر والرق والهموم والأحزان التي تطرقه وتفضي به إلى الهوى الداعي إلى ضد الغرض المقصود بهذا الباب، ينبغي أن يتذكر ويخطر بباله أولا ما مر لنا في فضل العقل والأفعال العقلية، ثم ما ذكرنا في زم الهوى وقمعه ولطيف مخادعه ومكايده وما قلنا في اللذة وحددناها به، ثم ليجد التثبت والتأمل ويكرر قراءة ما ذكرنا في باب الحسد حيث قلنا إنه ينبغي للعاقل أن يتأمل أحوال الناس وما ذكرنا في صدر باب دفع الغم حتى يقتلها فهما وتستقر وتتمكن في نفسه، ثم ليقبل على فهم ما نقول في هذا الموضع.
أقول: إنه من أجل ما لنا من التمثيل والقياس العقلي كثيرا ما نتصور عواقب الأمور وأواخرها فنجدها وندركها كأن قد كانت ومضت فنتنكب الضارة منها ونسارع إلى النافعة. وبهذا يكون أكثر حسن عيشنا وسلامتنا من الأشياء المؤذية الرديئة المتلفة. فحّق علينا أن نعظم هذه الفضيلة ونجلها ونستعملها ونستعين بها ونمضي أمورنا على إمضائها إذ كانت سبيلا إلى النجاة والسلامة ومفضلة لنا على البهائم الهاجمة على ما لا تتصور أواخره وعواقبه. فلننظر الآن بعين العقل البريء من الهوى في التنقل في الحالات والمراتب لنعلم أيها أصلح وأروح وأولى بالعقل طلبه ولزومه ونجعل مبدأ نظرنا في ذلك من هاهنا. فنقول: إن هذه الأحوال ثلاث، الحالة التي لم نزل عليها وربينا ونشأنا فيها، والتي هي أجل وأعلى منها، والتي هي أدنى وأخس منها. فأما أن النفس تؤثر وتُحبّ وتتعلق من أول وهلة بغير نظر ولا فكر بالحالة التي هي أجل وأعلى فذاك ما نجده من أنفسنا، غير أنا لا نأمن أن يكون ذلك ليس عن حكم العقل بل عن الميل وبدار الهوى. فلنستحضر الآن الحجج والبراهين ونحكم بعد بحسب ما توجبه فنقول: إن التنقل من الحالة التي لم نزل عليها المألوفة المعتادة لنا إلى ما هو أجل منها إذا نحن أزلنا عنها الاتفاقات النادرة العجيبة لا يكون إلا بالحمل على النفس وإجهادها في الطلب. فلننظر أيضا هل ينبغي لنا أن نجهد أنفسنا ونكدها في الترقي إلى ما هو أجل من حالتنا التي قد اعتدناها وألفتها أبداننا أم لا. فنقول: إن من نمى بدنه ونشأ ولم يزل معتادا لأن لا يؤمره الناس ولا تسير أمامه وخلفه المواكب إن هو اهتم واجتهد في بلوغ هذه الحالة فقد مال عن عقله إلى هواه وذلك أنه لا ينال هذه الرتبة إلا بالكد والجهد الشديد وحَملِ النفس على الهول والخطر والتغرير الذي يؤدي إلى التلف في أكثر الأحوال، ولن يبلغها حتى يصل إلى نفسه من الألم أضعاف ما يصل إليه مكن الالتذاذ بها بعد المنال. وإنما يخدعه ويغرُّه في هذه الحال تصوُّره نيل المطلوب من غير أن يتصور الطريق إليه كما ذكرنا عند كلامنا في اللذة. حتى إذا نال ووصل إلى ما أمل لم يلبث إلا قليلاً حتى يفقد الغبطة والاستمتاع بها، وذلك أنها تصير عنده بمنزلة سائر الأحوال المعتادة المألوفة، فيقل التذاذهُ بها وتشتد وتغلظ المؤن عليه في استدامتها والتحفظ بها ولا يمكنه الهوى من تركها والخروج عنها - كما ذكرنا عند كلامنا في زمّ الهوى - فإذا هو لم يربح شيئاً وخسر أشياءِ. وأما قولنا إنه لم يربح شيئاً فمن أجل أن هذه الحالة الثانية إذا هو ألفها واعتادها صارت عنده بمنزلة الأولى وسقط عنه سروره واغتباطه بها. وأما قولنا إنه خسر أشياء كثيرة فالعناء أولاً والخطر والتغرير الذي يُسلكه إلى هذه الحالة. ثم الجهد في حراستها والخوف من زوالها والغم عند فقدها والتعويد للنفس الكون فيها وطلب مثلها. وكذلك نقول في حالة تفوق الكفاف. وذلك أن مَن كان بدنُه معتاداً للغذاء اليابس واللباس المتوسط إن هو جهد نفسه حتى يتنقل عنهما إلى الغذاء اللين واللباس الفاخر فإن شدة التذاذه بهما تسقط عنه إذا اعتادهما حتى يصيرا عنده بمنزلة الأولين ويحصل عليه من فضل العناء والجهد في نيل هذين واستدامتها والخوف من تنقُّلهما عنه واعتياد النفس لهما ما كان موضوعا عنه قبل ذلك.
وكذلك نقول في العز والجاه والنباهة وسائر المطالب الدنيائية إذ ليس من مرتبة تُنال ويُبلغ إليها إلا وُجد الاغتباط والاستمتاع بها يقل بعد نيلها ويصغر في كل يوم حتى يضمحل وتصير عند نائلها بمنزلة الحالة التي عنها انتقل ومنها ارتقى ويحصل عليه من أجلها فضل مؤن وغموم وأحزان لم تكن فيما مضى. وذلك أنه لا يزال يستقل لنفسه ما هو فيه ويجتهد في الترقي إلى ما هو أعلى منه ولا يصير إلى حالة ترضاها نفسه بتّةً بعد وصوله إليها وتمكنه منها. فأما قبل الوصول فقد يريه الهوى الرضى والقنوع بالحالة المقصودة، وذلك من أعظم خُدَعِهِ وأسلحته ومكايده في اجتهاده وجَرِّه إلى الحالة المطلوبة، حتى إذا حصلت له تطلّع إلى ما هو فوقها. ولا تزال تلك الحالة حاله ما صاحب الهوى وأطاعه، نحو ما قلنا في هذا الكتاب إنه من أعظم مكايد الهوى وخُدَعه، من أجل أن الهوى يتشبه في مثل هذه الأحوال بالعقل ويدلِّس نفسه ويوهم أنه عقلي لا هوائي وأن ما أراه خيرة لا شهوة بأن يدلِّى ببعض الحِجاج ويقنع بعض الإقناع، لكن إقناعه وحجته هذه لا يلبث إذا قوبلت بالنظر المستقيم أن تدحض وتبطل. والكلام في الفرق بين ما يريه العقل وبين ما يريه الهوى باب عظيم من أبواب صناعة البرهان ليس نقله إلى هذا الموضع اضطرارياً، لأنا قد لوحنا منه في غير موضع من كتابنا هذا يما نكتفي به في غرضه، ولأنا ذاكرون جُملاً منه مجزئةً كافيةً لِما يراد منه في بلوغ مغزى هذا الكتاب، فأقول: إن العقل يُرى ويختار ويؤثر الشيء الأفضل الأرجح الأصلح عند العواقب وإن كان على النفس منه في أوائله مؤنه وشدة وصعوبة. وأما الهوى فأنه بالضد من هذا المعنى، وذلك أنه يختار أبداً ويؤثر ما يدفع به الشيء المؤذي المماس الملازق له في وقته ذلك وإن كان يُعقب مضرةً، من غير نظرٍ فيما يأتي من بعد ولا روية فيه. مثال ذلك ما ذكرنا قبل عند الكلام في زم الهوى من أمر الصبي الرمد المؤثر لأكل التمر واللعب في الشمس على أخذ الهليلج والحجامة ودواء العين. والعقل يرى صاحبه ما له وعليه، فأما الهوى فإنه يرى أبداً ما له ويعمى عمّا عليه. ومثال ذلك ما يَعمى عنه الإنسان من عيوب نفسه ويبصر قليل محاسنه أكثر مما هي. ولذلك ينبغي للعاقل أن يتهم رأيه أبداً في الأشياء التي هي له لا عليه ويظن به أنه هوى لا عقل ويستقصي النظر فيه قبل إمضائه. والعقل يرى ما برى بحجة وعذر واضح، وأما الهوى فإنه إنما يقنع ويرى بالميل والموافقة لا بحجة يمكن أن ينطق بها ويعبر عنها وربما تعلق بشيء منذ ذلك إذا أخذ يتشبه بالعقل، غير أنه حجاج ملجلج منقطع وعذر غير بين ولا واضح. ومثال ذلك حالة العشاق والذين قد أُغروا بالسكر أو بطعام رديء ضار وأصحاب المذهب ومن ينتف لحيته دائباً ويعبث ويولع بشيء من بدنه، فإن بعض هؤلاء إذا سئل عن عذره في ذلك لم ينطق بشيء بتةً ولا كان عنده في نفسه شيء يمكن أن يحتج به أكثر من ميلٍ إلى ذلك الشيء وموافقته ومحبةٍ طبيعية غير منطقية. وبعضهم يأخذ ويحتج ويقول فإذا نقض عليه رجع إلى اللجلجة والتعلق بما لا معنى تحته واشتد ذلك عليه وغضب منه وأبلغ إليه ثم ينقطع ويثوب بعد ذلك. فهذه الجمل كافية في هذا الموضع من التحفظ من الهوى والمرور معه من غير علم به.
وإذ قد بينا في الترقِّي إلى الرتب العالية من الجهد والخطر واطراح النفس فيما تغتبط ولا تُسر به إلا قليلاً، ثم تكون عليها منه أعظم المؤن والشدائد مما كان موضوعاً عنها في الحالة الأولى ولا يمكنها الإقلاع والرجوع عنه، فقد بان أن أصلح الحالات حالة الكفاف والتناول لذلك من أسهل ما يمكن من الوجوه وأسلمها عاقبةً، ووجب علينا أن نؤثر هذه الحالة ونقيم عليها إن كنا نريد أن نكون ممن سعد بعقله وتوقى به الآفات الرابصة الكامنة في عواقب اتباع الهوى وإيثاره ويكمل لنا الانتفاع بالفضل الإنسي، وهو النطق الذي قد فضلنا به على البهائم. فإن نحن لم نقدر ولم نملك الهوى هذه الملكة التامة التي نطرح معها عنا كل فاضل عن الكفاف فلا أقل من أن يقتصر مَن كان معه منا فضلٌ عن الكفاف على حالته المعتادة المألوفة ولا يكد نفسه ويجهدها ويخاطر بها في التنقل عنها. فإن اتفق لنا التمكن من حالة جليلة من غير جهدٍ للنفس ولا غرر بها فإن الأصلح والأولى ترك الانتقال إليها، لأنا لا نعدم منها الآفات التي عددناها العارضة لنا عن بلوغ الرتبة التي قصدناها بعد نيلها وبلوغها. فإن انتقلنا إليها فينبغي أن لا نغير شيئاً مما به قوام أجسادنا من المآكل والمشارب والملابس وسائر ما يتبع ذلك من حالاتنا وعاداتنا الأولى لئلا تكسب أنفسنا عادةَ فضلٍ من السرف وحالةً تطالبنا بها إن فقدت هذه الحالة الثانية، ولئلا يبلغ الغم إلينا بفقدها متى فقدت، وإلا كنا منحرفين عن عقولنا إلى هوانا وواقعين لذلك في البلايا التي ذكرناها.
في السيرة الفاضلة
إن السيرة التي بها سار وعليها مضى أفاضل الفلاسفة هي بالقول المجمل معاملة الناس بالعدل والأخذ عليهم من بعد ذلك بالفضل واستشعار العفة والرحمة والنصح للكل والاجتهاد في نفع الكل، إلا مَن بدأ منهم بالجور والظلم وسعى في إفساد السياسة وأباح ما منعته وحظرته من الهرج والعبث والفساد ومن أجل أن كثيراً من الناس تحملهم الشرائع والنواميس الرديئة على السيرة الجائرة كالديصانية والمحمرة وغيرهم ممن يرى غش المخالفين لهم واغتيالهم، والمنانية في امتناعهم من سقى مَن لا يرى رأيهم وإطعامه ومعالجته إن كان مريضاً، ومن قتل الأفاعي والعقارب ونحوها من المؤذية التي لا طمع في استصلاحها وصرفها في وجهٍ من وجوه المنافع، وتركهم التطهر بالماء ونحوها من الأمور التي يعود ضرر بعضها على الجماعة وبعضها على نفس الفاعل لها، ولم يمكن نزع هذه السيرة الرديئة عن هؤلاء وأشباههم لألا من وجوه الكلام في الآراء والمذاهب، وكان الكلام في ذلك مما يجاوز مقدار هذا الكتاب ومغزاه، لم يبق لنا من الكلام في هذا الباب إلا التذكير بالسيرة التي إذا سار بها الإنسان سلم من الناس وأُعطي منهم المحبة. فنقول إن الإنسان إذا لزم العدل والعفة وأقل من مماحكة الناس ومجاذبتهم سلم منهم على الأمر الأكثر، وإذا ضم إلى ذلك الإفضال عليهم والنصح والرحمة أُوتي منهم المحبة. وهاتان الخلتان هما ثمرتا السيرة الفاضلة، وذلك كافٍ في غرضنا من هذا الكتاب.
في الخوف من الموت
إن هذا العارض ليس يمكن دفعه عن النفس كَمَلاً إلا بأن تُقنَع أنها تصير من بعد الموت إلى ما هو أصلح لها كانت فيه. وهذا بابٌ يطول الكلام فيه جداً إذا طُلب من طريق البرهان دون الخبر. ولا وجه للكلام فيه البتة لا سيما في هذا الكتاب، لأن مقداره كما ذكرنا قبل يجاوز مقداره في شرفه وفي عرضه وفي طوله، إذ كان يحوج إلى النظر في جميع المذاهب والديانات التي تُرى وتوجب للإنسان أحوالاً من بعد موته، والحكم بعد لمُحقها على مُبطلها. وليس بصعوبة مرام هذا الأمر وما يضطر ويحتاج إليه فيه من طول الكلام خفاء. فنحن لذلك تاركوه ومقبلون على إقناع من يرى ويعتقد أن النفس تفسد بفساد الجسد، فإنه متى أقام على الخوف من الموت كان مائلاً عن عقله إلى هواه.
فنقول: إن الإنسان على قول هؤلاء ليس يناله من بعد الموت شيء من الأذى بتةً، إذ الأذى حس والحس ليس إلا للحي وهو في حال حياته مغمور بالأذى منغمس فيه، والحالة التي لا أذى فيها من الحالة التي فيها الأذى، فالموت إذاً أصلح للإنسان من الحياة. فإن قال قائل إن الإنسان وإن كان يصيبه في حال حياته الأذى فإنه ينال من اللذات ما ليس يناله في حال موته، قيل له: فهل يتأذى أو يبالي أو يضره بوجه من الوجوه في هذه الحال أن لا ينال اللذات؟ فإذا قال لا - وكذلك يقول لأنه إن لم يقل ذلك لزمه أن يكون حياً في حال موته، إذ الأذى إنما يلحق الحيَّ دون الميت - قيل له: فليس يضره أن لا ينال اللذات. وإذا كان ذلك كذلك فقد رجع الأمر إلى أن حالة الموت هي الأصلح، لأن الشيء الذي حسبت أن للحي به الفضل هي اللذة وليس بالميت إليها حاجة ولا له إليها نزوع ولا عليه في أن لا ينالها أذىً كما ذاك للحي، فليس للحي عليه فضل فيها لأن التفاضل إنما يكون بين المحتاجين إلى شيءٍ ما إذا كان لأحدهما فضل مع قيام الحاجة إليه، فأما أن يكون المحتاج على غنى فلا. وإذا كان ذلك كذلك فقد رجع الأمر إلى أن حالة الموت أصلح. فإن قال إن هذه المعاني ليس ينبغي أن تقال على الميت لأنها ليست له بموجودة، قيل له: إنا لم نقل عليه هذه المعاني على أنها قائمة موجودة له بل إنما نضعها متوهمة متصورة لنقيس شيئاً على شيء ونعتبر شيئاً بشيء. وهذا باب متى منعته كنت منقطعاً في قوانين البرهان، وهو باب من الانقطاع معروف عند أهل البرهان يسمونه غلق الكلام. وذلك أن صاحبه يغلق الكلام أبداً ويهرب منه ولا يساعد عليه خوف من أن يتوجه عليه الحكم. فإذا لجأ إلى التكرار واللجلجة فليس له بعد هذا ألا هذا أعلم إن حكم العقل في أن حالة الموت أصلح من حالة الحياة على حسب اعتقاده في النفس، وقد يوجد أنه مقيم على إتباع الهوى فيه. فإن الفصل بين الرأي الهوائي والعقلي هو أن الرأي الهوائي يُجتبى ويؤثر ويتبع ويتمسك به لا بحجة بينة ولا بعذر واضح وإنما يكون عن ضرب من الميل إلى ذلك الرأي والموافقة والحب له في النفس وأما الرأي العقلي فإنه يجتبى بحجة بينه وعذرٍ واضح وإن كانت النفس كارهة له ومنحرفة عنه. وأيضا فما هذه اللذة المرغوب فيها المتنافس عليها، وهل هي في الحقيقة إلا راحة من المؤلم على ما قد بينا؟ وإذا كان ذلك كذلك فإنه ليس يتصورها مقصودة مطلوبة إلا الجاهل بها، لأن المستريح من الأذى غني عن الراحة التي متى أعقبته سميت لذة. وأيضا فإنه وإن كان الاغتنام بما لا بد منه ومن وقوعه فضلا كما بينا قبل وكان الموت مما لا بد منه ومن وقوعه فإن الاغتنام بالخوف منه فضل والتلهي عنه والتناسي له ربح وغنم. ومن أجل ذلك صرنا نغبط البهائم في هذا المعنى إذ لها بالطبع هذه الحالة كملا التي ليس نقدر نحن عليها إلا بالحيلة لاطراح الفكر والتصور العقلي. وكأن ذلك من أنفع الأمور في هذا الموضع إذ كان يجلب من الألم أضعاف أضعاف المنتظر. وذلك أن المتصور للموت الخائف منه يموت في كل تصويره موتة، فتجتمع عليه من تصوره له مدة طويلة موتات كثيرة. فالأجود إذا والأعود على النفس التلطف والاحتيال لإخراج هذا الغم عنها. وذلك يكون كما قيل قبيل إن العاقل لا يغتم بتّة. وذلك أنه إذا كان لما يغتم به سبب يمكنه دفعه جعل مكان الغم فكرا في دفع السبب، وإن كان مما لا يمكن دفعه أخذ على المكان في التلهي والتسلي عنه وعمل في محوه وإخراجه عن نفسه. وأيضا فإني أقول: إني قد بينت أنه ليس للخوف من الموت على رأى من لم يجعل للإنسان حالة وعاقبة يصير إليها بعد موته وجه. وأقول إنه يجب أيضا في الرأي الآخر - وهو الرأي الذي يجعل لمن مات حالة وعاقبة يصير إليها بعد الموت - أن لا يخاف من الموت الإنسان الخير الفاضل المكمل لأداء ما فرضت عليه الشريعة المحقة، لأنها قد وعدته الفوز والراحة والوصول إلى النعيم الدائم. فإن شك شاك في هذه الشريعة ولم يعرفها ولم يتيقن صحتها فليس له إلا البحث والنظر جهده وطاقته. فإن أفرغ وسعه وجهده غير مقصر ولا وان فإنه لا يكاد يعدم الصواب. فإن عدمه - ولا يكاد يكون ذلك - فالله تعالى أولى بالصفح عنه والغفران له إذ كان غير مطالب بما ليس في الوسع بل تكليفه وتحميله عز وجل لعباده دون ذلك كثيرا.
وإذ قد أتينا على قصد كتابنا هذا وبلغنا آخر غرضنا فيه فإنا خاتمون
كلامنا بالشكر لربنا عز وجل. فالحمد لله واهب كل نعمة وكاشف كل غمة حمدا
بلا نهاية كما هو أهله ومستحقه.

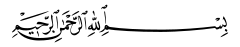
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق